- إبراهيم بن ممدوح الشمري
- ترير: فاطمة إنفيص
قصتي مع البحث العلمي لا تختلف كثيرًا عن قصة طفل مع مدرسته؛ دخلها اليوم الأول فلفحته وجوه الغرباء، حاول أن يتدارك أباه عند الباب ليتعلق بأهدابه فيعود معه من حيث أتى، لكنه لم يرَ إلا السراب يتقطع دون خطاه!
رام أن يتأقلم مع أهل المدرسة من أساتيذ وتلاميذ، فلم يفلح، لا يعرف الأسماء، ولم يأنس بالقرناء، فامتلأت نفسه بموج من البغض للمدرسة، والحنق على أهلها.
ثم مع مرور الأيام صار يأنس بجليسه في الفصل عمرو وزيد، ويطرب لثناء أستاذه بكر وعُبيد، وكلما ذهبت الوحشة حلت الألفة، وذابت النفرة.
وهكذا كنت تمامًا؛ أنظر إلى البحث العلمي بتوجس وريبة، وتزدحم في نفسي معانٍ قاتلة:
أي ثغرة يمكن أن أنفذ منها إلى ابتكارِ جديد، أو رصف معنى فريد؟، خاصة حينما تتسمّر عيناي أمام رفوف جدار واحد، دون أن تحيط بالكتب كلها نظَرًا!.
فأنّى لمثلي أن يجد مفحص قطاة بين تلك الجموع التي تطلّ برأسها من قرون متعاقبة!، وربما هتف في نفسي قول المتشائم:
لم يترك الأول للآخر شيئًا؛ فكلما فتشت في المدونات رأيت ما لم يخطر لي على بال، فهل يُعقل أن معنى ندّ عن تلك البصائر، أو مبنى سقط من تلك الأنامل؟
ثم بعد اختتام رحلتي البحثية المكتنزة بالفرح والترح، والإبداع والإخفاق، والانطلاق والانغلاق، رأيت أنني ذلك الفتى الذي يقف في حفل تخرجه، وينظر إلى ذلك الحقل الذي قضى فيه قطعة من حياته، والذكريات تمر أمام عينيه، فيلتذ بحلاوتها قليلًا، وبمرارتها طويلًا، كيف وقد نجا منها بعد أن كان من الغرق قاب قوسين أو أدنى، فاسمحوا لي أن أروي شيئًا من فوائد تلك الرحلة البحثية:
١- حققت أن تلك الكتب التي أمام أعيننا تتزاحم، وهيبتها في قلوبنا تتراكم، لم تُحِط بكل شيء علمًا؛ فما أكثر التكرار فيها والاجترار، فكثيرٌ منها حظّ صاحبها التقريب والتهذيب، والتصفية والتشذيب، فما الإبداع فيها إلا للمجلّي دون المصلي!
وما أحسن قول الفقيه الحنبلي نصير الدين السامري في مطلع كتابه الشهير (المستوعب) وهو قوله: (وكيف لم يترك الأول للأخير شيئًا وترتيب العلوم إنما هو من نتائج العقول، وقد منح الله العقول للأخير كما منحها للأول، … وليس كلمة أضر بالعلم من قولهم: ما ترك الأول للأخير شيئًا؛ إذ كان يقطع عن العلم والتعلم، ويقتصر الأخير على ما قدّمه الأول…).
ثم إن أولئك المؤلفين كأسراب القطا التي يحاكي بعضها بعضًا؛ فما توارد الأوائل على ذكره ذكروه، وما تجاهلوه تركوه!
ومن أجل ذلك فإنني أقول بكل ثقة: إن ما ترك الأول أكثر مما ذكر، والمسائل غير المبحوثة أكثر من المبحوثة!
فإن قلت: ما سبب ذلك؟
قيل: إن كثيرًا من تلك المصنفات كُتبت حفظًا لمادة العلم، ولم تكن بحوثًا يتغيّا فيها أصحابها تحقيق المباحث العلمية، ولذلك فإن رسائل العلماء في مسائل مخصوصة تجد فيها من التدقيق والتحرير ما ليس في شروحهم التي يعتمدون فيها على مصادر سابقة، ويتحرون فيها الإحسان إلى الطلاب المبتدئين.
٢- أن توليد الأفكار والرؤى غاية شريفة ليست بالأمر القريب، فربما كان في ذلك تفتيق العقول على ابتكارات عظيمة، وتحريرات نفيسة، وتقريرات بديعة.
وكلما استجاب النظر النقاد، والبصر الوقاد؛ انبلجت أسارير الحقائق، وتكشفت ثنايا البحوث الدقائق!
فهل يستويان مثلاً:
رجل يمتح من بئرٍ ماؤها هماج، وآخر من ينبوع ثجاج؟
وإلا فأين لنا بدائع الصنائع لولا الأذهان الجياد، والأفكار الحسان؟
٣- لا تستنكف أن تعرض ما جنته يداك من نتائج الأفكار، ورسوم الأحبار، على حاذق حصيف؛ فإن الناقد بصير، والباحث ضرير؛ فعسى أن تكون مرآته ذات جلاء، ترى فيها عقلك منشورًا بلا طلاء، فتدرك ما لحق بحثك من عوار، وما احتف به من عثار، فينقّي لك الآراء من أوضار الزلل، ويرفو ما فيها من خلل؛ ولا تعجب فـ(إن الخوافي قوةٌ للقوادمِ)، خاصة إن كان صاحبك متخصصًا في بابه، فهذا هو غاية المنتهى؛ إذ سيتجاوز بك كل المقدمات العقيمة، والتقريرات السقيمة، ويضع يدك على جراح المسألة التي تثعب إشكالًا، وتنضح إبهامًا، وبذلك يصبح بحثك أكثر إحكامًا، وأحسن قوامًا.
٤- أن التعبير قنطرة التحرير، والنفس تفيض عند امتلائها، وما بين معان تطيش، وحروف تجيش، تتدفق الأفكار الضرائر، والألفاظ الحرائر؛ فازبرها على طرس منشور؛ لتصبح أعز من كليب وائل، وأمنع من آساد الخمائل، فتورّث لك مجدًا مؤثلًا، وولدًا مخلدًا.
٥- الثقة بالنفس الدفينة بين الأضلاع؛ فما لم تأذن لها أن تصول وتجول، وتكتب وتقول؛ فستظل حبيسة في مكان قصي عن مراقي الإبداع، ومصاعد الإتقان، فلا تحقرن نفسك التي تجهل (أنت) أي شيء هي؛ لأجل أن عينك غشاها نور الآخرين حتى أعشاها.
افسح لقلمك أن يتنفس الصعداء فقد طال سكونه، وامتلأت باليأس عيونه، فإن له في البحث العلمي سبحًا طويلًا، ولا تنسَ ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم قيلًا﴾.




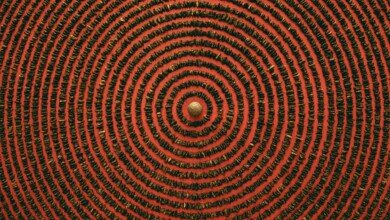
لا فض فوك
سلمت أيها المبارك