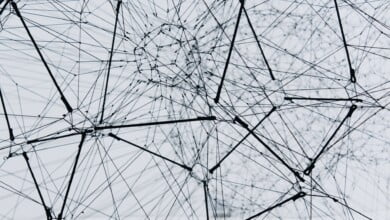محمد حسن إبراهيم
الإهداء:
إلى الشيخ محمّد بن عبد الغفّار، المُتَألِّق بالطيبة.
1- تقديم:
هذه الورقةُ العلميةُ الصغيرةُ تمرينٌ هرمنيوطيقيّ في المُحايَثةِ المُمَضاعَفةِ، وهي مفهومٌ حدَثيّ جرى تقديمُه في ورقةٍ علميّةٍ محكمةٍ على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث بعنوانِ “المُحايَثةُ المُمَضاعَفةُ والجلاليّةُ والإتيقا بينَ التفجّي والصمديّة (بحثٌ في الاستعدادِ الهيولانيّ للعقلِ والجسمِ والفنِّ والاستطيقا ما بعدَ الأنطو-لاهوت)”. مِن إمكانيّاته تفسيرُ ما سُمّي في تلك الورقةِ بـ”الشرطِ التعبيري عبر النقيض”، حيثُ إنَّ الميتافيزيقا حتى تُعبِّر عن مقولاتها تستعيرُ لغةَ الفيزيقا وتستعيرُ الفيزيقا مقولاتِ الميتافيزيقا لتعبّرَ عن مقولاتِها كما بيَّنّا بأمثلةَ كثيرةٍ عليها؛ لذا فهي تعتبر علاقةَ المتقابلاتِ والمتضاداتِ في السياقِ الفلسفيِّ واللاهوتيِّ زوجيّاتٍ بعضها مِن بعضٍ. ومن هذا السياقِ الكبيرِ والعامِ ننزِلُ في هذه الورقةِ إلى سياقٍ أضيَقَ وأخصَّ، وهو سياقٌ يضعُ السردَ الشعريَّ القرآنيَّ في تقابُلٍ مع المنطقيِّ الإبستمولوجيِّ، ثمّ يعثُرُ على وحدةٍ بينهما لِيُبيّنَ عملَ المُحايَثةِ المُضاعَفةِ في الهرمنيوطيقا. وتَنتمي المُحايَثةُ المُضاعَفةُ إلى الهرمنيوطيقا من جانبِ كونِها إجراءً من إجراءاتِ الفهم، وتحتَ هذا التعريفِ الأعمِّ يكادُ لا يخلو عملٌ أو طرحٌ معرفيٌّ منها؛ فهو إن كانَ تصحيحًا لشيءٍ فقد طهّرَ الفهمَ من إجراءاتٍ تحيدُ به عن أن يبلغَ مقصده، وإن كان يُقدّمُ طرحًا مستجدًا فقد أمدَّ الفهمَ بإجراءٍ يساعده ويُمكّنه من أن يبلغَ مقصده.
وبالنظرِ إلى النصوصِ الإبراهيميةِ التوحيديةِ فإنَّ المُحايَثةَ المُضاعَفةَ تعِدُّ بالكثير؛ لأنَّ دعاوى الفَرقِ والتضادِّ التي ما فتئتْ من بعدِ عصرِ التنوير تتنامى تجاه العلاقةِ بين الإيمانِ والتفلسفِ. سَيَقِفُ قُبالتها مفهومٌ يستثمرُ التضادَّ والتناقضَ لقولِ الشيءِ عينه، فيُولِجُ الضدَّ في ضدهِ والنقيضَ في نقيضِه ويُخرِجَه منه؛ وبذلك فإنَّه مهما طرأَ من مستجدٍّ في الفكرِ بعامّةٍ فإنَّ المزاعمَ الخاصةَ بالنصوصِ الإبراهيميةِ التوحيديةِ ستصِيرُ كالحُدودِ التي يُمتحَنُ عليها تناهيها؛ بمعنى: هل يُمكِنُ أن تُصدِرَ في حالةِ أخذنا بالمُحايَثةِ المُضاعَفةِ غيريّةً أم لا؟ وسنبدأ هذه الورقةَ بتعريفٍ موجزٍ للمُحايَثةِ المُضاعَفةِ، ثمّ نتوجَّهُ إلى سورةِ يوسفَ كجزءٍ من خطابٍ ذي بُنيةٍ سرديةٍ شعريةٍ إيمانيةٍ وهو القرآن الكَرِيم، ثمَّ ننتقِلُ إلى إبستمولوجيا ليبنتز، حاصدينَ من كلِّ خطابٍ صِيَغًا ثلاثًا هي صِيَغُ للكوننةِ أو التحوّلِ والتغيّرِ والتصييرِ. فإذا وجدنا بين صيغِ الخطاباتِ المتضادّةِ هذه وحدةً استبانَ لنا كيفَ أنّ هذه الثنائياتِ هي زوجيّات؛ وبالطبع فإنّ الخطابَ الشعريَّ هنا هو وَحيٌّ ومصدرُه ليسَ الإنسانُ، في حين أنّ الثاني مصدرُه الإنسانُ. وعليه فإنّ العلاقةَ الزوجيّةَ بينَ الخطابين ستعني أنّ الخطابَ الذي مصدرُه ليسَ إنسانيًّا يخصُّ الإنسانَ خصَّ الخطابَ الموجَّهَ من الإنسانِ إلى الإنسانِ، بل يخصُّه أكثر ما دامَت المُحايَثةُ المُضاعَفةُ تجعلُ من المتعالي محكًّا يُمتَحَنُ فيه الخطابُ الصادرُ عن المُتناهي.
1- تعريفٌ موجزٌ للمُحايَثةِ المُضاعَفةِ:
تعني المُحايَثةُ المُضاعَفةُ أنّ الشيءَ إذا رجعَ إلى نفسِهِ وطباقَها أي صارَ هو-هو فإنّه يُصدِرُ غيرَه. فالـ”هو” حينما يُضاعَفُ فإنّه يُثبِتُ ويؤكِّدُ امتيازًا، وهذا الامتيازُ الذي يُثبّتُ يثبَّتُ داخِلَ غيريّةٍ هي هويةٌ غيرُ راجعةٍ إلى نفسها ولا تُطابِقُها. وبذلك فإنّ الهويةَ الراجعةَ إلى نفسها هي حضورٌ؛ حينما يُضاعفُ فهو يكونُ داخلَ غيابٍ، وبما أنّ التطابقَ تعيُّنٌ والغيريّةُ بخلافِ ذلك فإنّ المُحايَثةَ المُضاعَفةَ هي ما يجعلُ الفرقَ فرقًا، أي أنّها مجالٌ للتمايز. ومن الممكنِ للغيريّة أيضًا أن توجد بذاتِ الكيفيةِ التي يوجدُ بحسبها المتطابقُ أو الهو-هو. وهي إذّاك لن تلتبسَ به بحيث يمتنعَ عزلُها عنه فتذوبَ فيه، ولن تنفصلَ عنه بحيث يستوجبَ وجودُها إلغاءَه أو العكسَ. وقد ضربنا في الورقةِ العلميّةِ التي قدّمنا فيها هذا المفهومَ الحَدَثيَّ أمثلةً سنعيدُ ذكرها هنا:
1- المثالُ الأوّل: حينما نقولُ إنّ التفاحةَ هي التفاحةُ، فإنّ مضاعفةَ الدالِّ أو محايثةَ المحايثِ هي امتيازُه بمدلولٍ معين. وهذا الامتيازُ الذي ينتجُ عن مضاعفةِ الدالِّ إنّما هو تعبيرٌ يُقرُّ بالمطابقةِ من خلالِ تأكيدِ الامتياز. وعليه فهو أيضًا تعبيرٌ يُقرُّ بغيريّةٍ؛ إذ الامتيازُ الذي يجري تأكيدُه من خلالِ الهو-هو هو امتيازٌ على شيءٍ أو بالنظرِ إلى شيءٍ آخر. إنّ وظيفةَ المضاعفة تعملُ عملَ الإبرازِ والإظهارِ الأشدِّ سورةً لما يمكن أن يتوارى في الهويةِ.
2- المثالُ الثاني: حينما يقولُ ميستر إيكهارت: «إنَّ اللهَ هوَ اللهُ وأنا إنسانٌ، فكن متيقنًا من هذا لأنّه حقٌّ، والحقيقةُ نفسها تشهد بذلك»، فإنّ الغيريةَ أو الاختلافَ إنّما تتضحُ حدودُهما من خلالِ المضاعفة. فمطابقةُ اللهِ لنفسهِ هي ذاتها ما جعلت الغيريةَ والاختلافَ يكونان بذاتِ الطريقةِ التي وُجدت بها المطابقةُ، أي كونُ الغيريةِ غيريّةً.
وهذا كافٍ لنبتَدرَ موضوعَ بحثِنا هذا وهو تمرينٌ على استخدامِ هذا المفهوم الحدَثي هرمنيوطيقيًا.
2- الصبوةُ إلى الجَهالةِ في سورةِ يُوسُفَ عليهِ السَّلامِ:
معلومٌ عن سورةِ يُوسُفَ في وعي المؤمنِ المسلمِ أنّها سورةُ التدبيرِ الفائقِ، حيثُ الشّرُّ وتوفيرُ سُبُلِ الهلاكِ كافةً أفضت إلى نقيضِه، أي الخيرِ وتوفيرِ سُبُلِ النعمةِ كافةً: من حريّةٍ وتنقّلٍ في الأرضِ حيثُ شاءَ الإنسانُ، إلى تَنَعّمٍ بخيراتِها وإلى قَضَائهِ بالعدلِ، حتى لمّ الشملِ وبزوغِ المحبّةِ بين الأقاربِ. أي أنّها سورةُ إقبالٍ تامٍّ للدنيا على الفردِ؛ لذا تبدو نهايةُ السردِ بالدعاءِ بالتوفّي على الإسلام وإلحاقِه بالصالحينَ مفهومةً بل وحتميّةً، إذ ما الذي يُرادُ بعدَ الحصولِ على كلِّ شيءٍ سوى التفرّغ لشيءٍ يتجاوزُ ما حُصِّلَ؟ لا شيءَ البتّة، إذ الرضا التامّ عن كلِّ ما سبقَ من ألمٍ وإهانةٍ وذُلٍّ قد انتهى بكلِّ لذّةٍ ورفعةٍ وعزّةٍ ممكنةٍ. ويهمُّنا في هذا المقالِ المحنةُ الأخيرةُ التي كانَ مِن بعدها هذا الفتحُ، أي محنةُ يُوسُفَ مع امرأةِ العزيزِ والنّسوةِ التي انتهت بسجنه ظلمًا وعدوانًا، والصِيغُ التي عبّرَ فيها القرآنُ الكريمُ عنها في شأنِ طرفَي السردِ في هذا الموضعِ. فقد قالت امرأةُ العزيز بعدَ عرضه على النّسوةِ اللاتي أردنَ مماكرَتَها ليرينَ فتاها أو عبدَها الذي راودَته عن نفسه وهي من هي في قومِها قائلةً: «لئن لم يفعلْ ما آمره ليُسجَنَنَّ وليَكُوناً مِنَ الصاغِرينَ»، في حين قالَ يوسفُ بعدها: «رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، إِلّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجاهلينَ». إنّ هذه السورة يجوزُ وصفها بالنظرِ إلى المعيشةِ الإنسانيةِ اليوميةِ والاجتماعيةِ باعتبارِها سورةَ الكوننةِ، أي التحويلِ والتغييرِ والقلبِ والهبوطِ والارتفاعِ؛ والكوننةُ تتعلّقُ بفعلِ الأفرادِ والشخوصِ. إلا أنّ الأفعالَ المكوِّنةَ لهم قد تضافَرَتْ جميعًا لتفعلَ تجاه قصدٍ لم يكونوا يريدونه؛ فإخوةُ يُوسُفَ أرادوا إخفاءَهُ بحيثُ لا يبينَ ليعقوبَ أباهُ ليكونوا همُ الصالحينَ والمعتَبَرينَ والمنظورين، لكنّه صارَ أظهرَ الظاهرين. ومن تمَّ بيعه لهم كعبدٍ لم ينظُروا فيه إلّا سبيلًا للتكسُّبِ صاروا هم بحكمِ أنّ يوسفًا قد صارَ عزيزَ مصرَ وملكَها، من يكسِبُ من خلالِهم. ومَن إشتراهُ عبدا صارَ هوَ وامرأته منه بمثابةِ الخدمِ.
نعودُ الآنَ إلى الكوننةِ في المحنةِ الأخيرة، وتستبينُ ثلاثُ دلالاتٍ للكوننةِ منها أنّ السِّجنَ قد أتى بصيغةِ التوكيدِ والجزمِ حيثُ نجدُ حرفَ النونِ مُضاعفًا ولا يلحقُ بهِ حرفُ الألف داخلَ الصيغةِ «ليُسجَنَنَّ»، وكوننةُ يوسفَ في السجنِ فقد أتت مُخفّفةً بتنوين النَّصبِ بالفتحة داخِلَ الصيغةِ «ليَكُوناً»، أما الكوننةُ التي رفضها يوسفُ وهي الاستجابةُ لما تريدُه وتدعو إليه امرأةُ العزيز والنّسوةُ فقد تمّ التعبيرُ عنها بأخفِّ ما يمكنُ من صيغِ الكوننةِ الممكنةِ للسياقِ وهي قولهُ «أَكُنْ». إنّ هذه الاختلافاتِ ليستْ نحويةً وبلاغيةً فحسب، بل هي مفعمةٌ ومشبعةٌ بدلالاتٍ عدةٍ نحصِرُها فيما يأتي:
1- دلالةٌ أداتية-استعماليّة: فامرأةُ العزيز وهي سيدةُ قومِها والمتصرِّفةُ في شؤونِهم إذا أرادت أن تكونَنّهم فهي قادرةٌ يقينًا على ذلك؛ لذا جاءت كلمةُ «ليُسجَنَنَّ» في صيغةِ التوكيدِ والجزمِ.
2- دلالةٌ أنطولوجية وقانونية-سوسيولوجية: بالنظرِ إلى القانونِ والمجتمعِ فإنّ يُوسُفَ هوَ البريءُ وهيَ الظالمةُ كما يعلمُ الجميع، لذا فإنّ كوننةَه منَ الصاغرينَ من خلالِ السجنِ جاءت بنونٍ مُخفّفةٍ أي «ليَكُوناً»؛ وهذه هي الدلالةُ القانونية-السوسيولوجية. أمّا الدلالةُ الأنطولوجيةُ فهي وضعُه في موضعٍ ليس بموضعِه، وبذلك فهي تعترفُ ضمنًا ببراءتهِ.
3- دلالةٌ أنثروبولوجية-سيكولوجية وإيتيقية: وهي في قولِ يوسفِ عليهِ السلامِ «أَكُن»؛ ففيها اعترافٌ ضمنيٌّ بأثرِ الآخرِ في حياةِ الأنا واعترافٌ بالضعفِ والهشاشةِ الإنسانيةِ أمامَ الإغواء، وأخيرًا أنّ هذا البعدَ الأنثروبولوجيَّ-السيكولوجيَّ إن استسلمَ له سيحدِّده إتيقيًا ليصبح منَ الجاهلينَ سلوكيًا.
ومن هذه الدلالاتِ الثلاثِ للكوننةِ نريدُ أن نستخلصَ واقعةً تُشكّلُ نسيجَها جميعًا في السردِ الخاصِّ بهذه المحنةِ، وهي حدوثُ الحصارِ لامرأةِ العزيز كأثرٍ لفعلِ المراودةِ، وتوسُّعه حتى أصبحَ حصارًا ليوسُفَ عليهِ السلام، لا من جهتِها فحسب بل من جهةِ اللائمينَ لها على فعلِها من النّسوةِ؛ فقد تحوّلوا لأشباهِها بعدَ الإقرارِ بجلالةِ قدرِه حدَّ وصفه بالمَلك. وما دامَ قد بلغ هذا المبلغَ فإنّ يوسفًا عليهِ السلام باعتبارِه الشخصيةَ المحوريةَ في السردِ كلِّه بما في ذلك هذه المحنةِ، فإنَّ السجنَ يُعدُّ له حريّةً؛ لأنّ الدلالةَ الأداتية-الاستعماليةَ التي بحسبِها تتصرّفُ امرأةُ العزيز في الآخرين قد انتفتْ بفضلِ تفضيلِه للسجنِ، وبذلك تختفي طرًا سائرُ الدلالات.
والآن صارَ بإمكاننا أن نفهمَ حقّ الفهمِ كوننةَ يوسفَ عليهِ السلام لنفسِهِ بالجهلِ في حالةِ لم يتمَّ عزله عمّا هو محاصرٌ به، ولأجلِ ذلك نريدُ أن نحافظَ على طبيعةٍ مُجرّدةٍ للمسألةِ على الصورةِ الآتية: إنسانٌ في مواجهةِ حصارٍ، بغضِّ الطرفِ عن طبيعةِ ما يُحاصِره، وما يُحاصِرُ لا يرضى إلّا بأخذِ ما يريدُهُ ممّا يُحاصِره؛ إلا أنّه مهما كانت طبيعةُ ما يُحاصِرُنا فلابدّ أنّه ببساطةٍ «شيءٌ» يُحاصر وفاعلٌ يُنسبُ له فعلٌ، وإذا كان هذا هكذا فإنّ الفاعلَ هو راغبٌ ما دامَ فاعلًا لفعلهِ. إنّ المحاصِرَ إنْ هو راغبٌ أو مجموعةٌ من الراغبينَ، والزمنُ والمكانُ بجملتهِما صارَ داخلَ الرغبةِ. بالنظرِ لذلك فبإمكاننا أن نعتبرَ سورةَ يوسفَ وفي جزئيةِ محنته مع امرأةِ العزيز والنّسوةِ التي هي حصارُ الرغبةِ التي تبتلعُ الزمكانَ سورةً تجسّدُ كيفَ ترتبطُ الرغبةُ بالتأريخِ أو الحوادثِ والوقائعِ التي مِن عُهدهَا يُنظرُ إلى التغيُّراتِ والانعطافاتِ في مسارِ الكينونة، سواء كانت جماعيةً أو فرديةً. امرأةُ العزيز قبلَ المحنةِ وأثناءَها لم تعدْ هي بعدَ المحنةِ، والأمرُ ذاتهُ في شأنِ نبيِّ اللهِ يوسف عليهِ السلام؛ ومن هو في سدةِ الحكمِ أو التشريع قد تغيّرَ واستبدلَ بطبيعةٍ مغايرةٍ لمن كان فيها. فما الجهلُ إذا؟ ما الذي يخشاهُ النبيُّ يوسف؟ إنّه الصبوةُ والإرتماءُ في خضمِّ رغبةٍ تأريخيةٍ لكينونتهِ وكينونةِ ما يمثّلهُ، حاصرته بفضلِ زمكانٍ معيّنٍ، أو بكلمةٍ واحدةٍ: إنّ الجهلَ هو الرضى باختزالِ الكينونةِ في إمكانياتٍ من طرحِ المحاصِر؛ لذا فهو ليس نقيضًا للمعرفةِ، فهو سلفًا يعرِفُ ما يحاصِره، ولا هو بالراغبِ بأن يُحاصَرَ بغيرِ ما حوصِرَ به، بل هو يرفُض أن يكونَ فعلُ الحصارِ وما يُحاصَرُ من خلالهِ سواءٌ كانَ رغبةً أو غيرَها محدّدًا للكينونةِ جملةً وتفصيلاً. يمكنُ لنا أن نضربَ أمثلةَ بيِّنةً إلى حدٍّ بعيدٍ على ذلك في التجارةِ والتسويقِ: يذهبُ الواحدُ منا ملءَ إرادتهِ ليختارَ بضاعةً يبتاعُها، فيحاصرُهُ التاجرُ من كلِّ حدبٍ وصوبٍ، ثمّ إذا رضي بما حوصِرَ به ومضى في حالِ سبيله بقي شيءٌ في نفسه كعائقٍ عن الرضا بما ابتاعَهُ رغم أنّه من فعلِ ذلك؛ إنّ الحريّةَ هي سرُّ الرضا، لا عن الملكيةِ بل عن الإرادةِ نفسها وإن لم تصبْ هدفها.
3 – الصبوةُ إلى الجَهالةِ في إبستمولوجيا ليبنتز:
هل بالإمكانِ أن نجدَ في الإبستمولوجيا وبالتحديدِ علمِ المنطقِ تحديدًا للجهالةِ مماثلًا لما وجدناه في تأويليّةِ الكوننةِ الخاصةِ بمحنةِ يوسفَ عليهِ السلام مع امرأةِ العزيز؟ بَدهيٌّ في حدودِ القرنِ السادس عشرِ أنّ تحديدَ الإبستمولوجيا أو المعرفةِ هو المنطق. فما المعرفة؟ إنّها علاقةٌ بينَ موضوعٍ ومحمولٍ، وشرطُ هذه العلاقةِ هو عدمُ التناقضِ بين الموضوعِ والمحمولِ الذي يُنسبُ إليه. إنّها علاقةٌ بينَ شيئين (بعيدًا عمّا طرحَه كانطُ لاحقًا حول الأحكامِ التحليليّة). والتصريحُ السابقُ عن المعرفة هو ما يضعهُ فيلهلمُ ليبنتز على لسانِ المحاورِ Philalèthe/فيلاليث أو مُحبِّ الحقيقةِ، ويفتتحُ به محاورةَ الكتابِ الرابعِ من New Essays on Human Understanding، ليستخرجَ منه الطرفَ الآخرَ في المحاورةِ والمسمّى بـ Théophile/ثيوفيل كافّةَ تبعاتِه؛ إنّ ثيوفيل هو المحاورُ الذي يعملُ عملَ التصفيةِ لمقولاتِ فيلاليث التي تمثّلُ مقولاتِ الفلسفة وهو الممثّلُ لنظراتِ ليبنتز نفسه.
يفرِضُ سؤالٌ نفسَه علينا إذا أقررنا أنّ المعرفةَ هي علاقةٌ بين موضوعٍ ومحمولٍ، وهو: ألا يكونُ هذا التحديدُ للمعرفةِ كعلاقةٍ بين موضوعٍ ومحمولٍ تحديدًا للوجودِ بالكُليّةِ الحقيقيةِ منه والوهميِّ والمحضِّ والتجريبيِّ إن جازتْ هذه الثنائيات، بما أنّ الحقيقةَ هي مطابقةُ ما في الأذهانِ لما في الأعيانِ والوجودُ في الأذهانِ والأعيانِ باختلافِ نوعِه؟ وأيُّ معنىٍ يمكنُ أن يكتسبَهُ مفهومُ البُرهانِ وأيُّ دلالةٍ ممكنةٍ له إنْ كانَ كذلك؟ إنّ ما يجبُ التنبهُ إليه هنا أنّ هذا التعيينُ للمعرفة يجعلُ من أيِّ علاقةٍ بينَ موضوعٍ ومحمولٍ إذا كانت المعرفةُ معرفةً بالحقيقةِ حقيقةً، أنّها تبعًا للتعريفِ يمكنُ أن تُعدَّ صحيحةً قويمةً. فلو قلنا مثلاً في قضيّةٍ شرطيةٍ أنّ: الفرقعةَ بالإصبعِ تتسببُ في انفجارِ نجمٍ في مجرّةِ دربِ التبانةِ لكان ذلكَ حقيقيًا وصحيحًا. فما الذي يمكنُ أن ينسجمَ معه هذا التعريفُ حقّ الانسجام؟ هي المقولاتُ بما أنّها محمولٌ ضروريٌّ لأيِّ موضوعٍ ويحملُ عليها ما سواها مِنَ المحمولاتِ [1]. وقد فطنَ كانطُ لذلكَ في نقد العقل المحض، فهذا التعريفُ لا يأبهُ للجزئياتِ [2]. فلو قلنا مثلاً «أحمر» دونَ تحديدِ موضوعٍ هو أحمر، لكان ذلك حديثًا في الهواءِ خالٍ من الدلالةِ، أو كلامًا صامتًا لا يبلغُ شيئًا، وسنُسأل: ما هو الشيءُ الذي هو أحمرُ؟ هل هو سيارةٌ أم قلمٌ أم ماذا؟ لكنَّنا لو كنا نمشي بصحبةِ أحدهم فقلنا: «زمانٌ»، فإنّ الموضوعاتِ التي تظهرُ للوعي والتي تتعلقُ بالزمنِ لا حصرَ لها، ونكادُ لا نقولُ شيئًا طارئًا ومستجدًا، بل قد ينخرطُ مَن هو معنا ليتحدثَ في أشياءَ تتعلقُ بالزمنِ دون اعتبارِ الموضوعِ الذي نتحدّثُ عن زمانِه، ويَبقى لهذه الأشياءِ دلالتُها بالنظرِ لما نطقنا به وصرّحنا أيّ الزمانَ.
يطرأ بناءً على ما سبقَ تحوّلٌ حول مفهومِ العارفِ، فهو ليسَ مَن يعرِفُ الحقيقةَ (بقطعِ النظرِ عن المقولاتِ التي يعرفها كلُّ شخصٍ بالقوّة)، بل هو مَن يملكُ أكبرَ قدرٍ ممكنٍ من العلاقاتِ أو التوليفاتِ الممكنةِ بينَ الموضوعِ والمحمولِ[3]، ولا يهمُّ سواءٌ كانتْ موجودةً حقًّا أو لا. إنّ لهذا المفهومِ للمعرفةِ كعلاقةٍ بينَ الموضوعِ والمحمولِ جذورًا أفلاطونيةً، التي ترى في العدمِ أو غيابِ العلاقةِ بينَ الموضوعِ والمحمولِ ضربًا من الوجودِ، وهذا ما حدا بكواين في مناقشته لأزمةِ مفهومِ العدمِ في الأنطولوجيا للتصريحِ بأنّ افتراضَ وجودٍ للعدمِ قد أخّرَ العملَ بمِبضَعٍ أو نصلِ أوكام[4]. فإذا كانت المعرفةُ علاقةً موضوعًا ومحمولًا وكانت المعرفةُ معرفةً بالحقيقةِ، فكلُّ شيءٍ موجودٍ وحقيقيٌّ، سواءٌ كان حصانًا يطيرُ أو قرشًا يمشي على رجلين في إحدى الشوارعِ، وعلينا أن نأخذَ هذه العلاقاتِ بجدٍّ بالغٍ كجدِّنا تجاه أيِّ شيءٍ نتعاملُ معه كحديثٍ عن زحمةِ سيرٍ أو تعطّلِ إشاراتِ المرور. وبالمجملِ فإنّ هذا التحديدَ الأعمَّ سماهُ ليبنتزُ بالتحديدِ الأعمِّ[5].
أمّا التحديدُ الأخصُّ أو الأضيقُ للمعرفةِ فهو يستدخِلُ التجربةَ[6] أو ما يتقوّمُ ويتجوهرُ به الجزئيُّ فيها، وهو الذي بناءً عليه يتحددُ مفهومُ الإنسانِ كعارفٍ باعتباره يملكُ الحقيقةَ. بيدَ أنّه وفي شأنِ الحقيقةِ التجريبيةِ فإنّ العلاقةَ بين الموضوعِ والمحمولِ لا يُشترَطُ بها أن تُدرَك بصورةٍ متميِّزةٍ وواضحةٍ للوعي[7] إنَّ ليبنتزَ يطعّمُ الإبستمولوجيا الخاصةَ به بأنطولوجيا المونادولوجيا. ولنشرحْ الأمر: فإنّ التحديدَ الأعمَّ للمعرفةِ يُنتقَل منه إلى تحديدٍ أخصَّ، إلّا أنّ هذا الانتقالَ هو نزوعٌ (appétition) بمعنى أنّ التحديدَ الأعمَّ والمحضَّ الذي لا تمايزَ فيه بين الوهمِ والحقيقةِ وخواطرِ التمنّي وشطحِ الخيالِ إنّما ينزِعُ باشتهاءٍ لأن يُحدِثَ التحديدَ الأخصَّ ليعبِّرَ عن نفسه، لكنه لا يُحدِثُه كليًا وإلّا ما كان ثمّ من تحديدٍ أعَمَّ ولَكانَ مماثلًا للتحديدِ الأخصِّ. وبصورةٍ أدقٍّ فيمكن أن نقول: إنّ التحديدَ الأعمَّ والمحضَّ للمعرفةِ إنما يريدُ أن يتجانسَ ويختلطَ ويتركّبَ فيه غيرُه الذي هو التحديدُ الأخصُّ كمجالٍ ومنطِقةٍ لحدثانهِ، وثمَّ في عمليّةِ الانتقالِ هذه معنىَ البُرهانِ، فثمَّ مبدأٌ يصدرُ عنه شيءٌ أو مقدّمةٌ تنتجُ عنها نتيجةٌ ضروريةٌ متضمنةٌ في المبدأِ أو المقدّمةِ. وإذْ أنّ الفعلَ الداخليَّ للمونادةِ والذي ينزِعُ بها نحو الانتقالِ أو التغييرِ لا يبلغُ ما يُنتقَلُ نحوه أو يُتغيّرُ إليه بالتمامِ[8]، فإنّ الصورةَ العامةَ للبُرهانِ — والتي تشترطُ تضمّنَ السابقِ أي المبدأِ أو المقدّمةِ في اللاحقِ الذي هو النتيجة — تتّضحُ هنا الآن؛ فاللاحقُ أو الحالةُ التي كانت عليها المونادةُ وانتقلت وتغيّرت منها لابدَّ لها ألّا تنتقلَ وتغيّرَ تمامًا حتى تُبقى العلاقةُ والاتصالُ بين أجزائها أو حالاتها. وكذا الأمرُ في شأنِ البُرهانِ؛ حتى يكون برهانًا، هناك مشاركةٌ (methexis) من السابقِ في اللاحقِ. لكنَّ الحالةَ أو الجزءَ المشاركَ فيما انتقل وتغيّر إليه لا يتوجّهُ نحوَ الإدراكِ الواضحِ والمتميّزِ والمباشرِ بل يبقى في صيغةِ إحساسٍ أو شعورٍ غامضٍ[9].
علينا الآن أن نبينَ ما يمكنُ أن تكونَ عليه الجَهالةُ عندَ ليبنتز ثمّ نبحث لاحقًا عن تقاطعاتِها مع ما خلصنا إليه في سورةِ يوسف. ويتعيّنُ علينا لأجلِ ذلك أن نجدَ صيغَ الكوننةِ التي وصلنا إليها من خلالِ تحليلِنا اللغويِّ للنونات (مجموعُ النون)، ونبدأ حتى نتحصّلَ على ما يمكنُ أن تكونَ عليه الجَهالةُ بالنظرِ في مفهومِ «العامِّ»، فنقول: إنّ العامَّ هو الشاملُ والسورُ الذي يحيطُ جملةَ شيءٍ، وما دامَ التحديدُ للمعرفةِ كعلاقةٍ بين موضوعٍ ومحمولٍ فإنّ هذا التحديد هو ما يحاصرُ كلَّ معرفةٍ وموجودٍ وحقيقةٍ، وهذا التحديدُ هو تحديدٌ للكينونةِ ومن ثمّ فإنّ أيَّ كوننةٍ تكونُ بحسبه. وحيثُ أنّ البنيةَ التي للبرهانِ — والذي هو خاصٌّ بالمعرفةِ بالمعنىِ الأخصِّ — ترفضُ الحِصارَ داخلَ تحديدِ المعرفةِ العامِّ كعلاقةٍ بين موضوعٍ ومحمولٍ وتستلزمُ الانتقالَ من مبدأٍ أو مقدّمةٍ إلى نتيجةٍ.
إنّ أوّلَ صيغةٍ للكوننةِ أو فعلِها هي التأزير[10]. والتأزيرُ هو التواجدُ معًا، وأقرَبُ ما يكونُ في معناه إلى “الإفْعام” الذي من دلالاته تزويدُ الشيءِ بما يحتاجُ ليوجدَ أو إقدارُه على أن يكون ما ينزِعُ إليه. وهو بذلك الصيغةُ المنطقيةُ الإبستمولوجيةُ الحقةُ لنزوعِ المونادةِ للتعبيرِ عن نفسها بالانتقالِ أو التغيّرِ غيرِ التامّ؛ فإذا فإنّ العلاقةَ بين الموضوعِ والمحمولِ في تعيّنها أو حدثانها التجريبيِّ لها طبيعةُ الفعلِ التأزيريِّ، وهو ما يتقوّمُ به ويتجوهرُ به الجزئيُّ في التجربةِ. فالعلاقةُ إذا بين المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ هي علاقةُ تأزيرٍ للمعنى الخاصِّ للمعرفةِ، ورغم أنّ ليبنتز يصرِّحُ على لسانِ ثيوفيل بأسبقيةِ المقارنةِ على المؤازرةِ[11]، إلّا أنّنا نجدُ أنفسنا مدفوعينَ لعكسِ الأمر ما دمنا نبحثُ عن علاقةٍ بين المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ والمعنىِ الخاصِّ.
أمّا الصيغةُ الثانيةُ للكوننةِ فيجبُ أن تُشتقَّ من الصيغةِ الأولى أي الكوننةِ عبر التأزيرِ، وسنعتبرُ المقارنة التي تتضمّنُ المطابقةَ والاختلافَ[12] هي اللاحقُ منطقيًا في العلاقةِ بين المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ والمعنىِ الخاصِّ، فهي متطابقةٌ مع المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ ومختلفةٌ عنها في ذاتِ الوقتِ داخِلَ عمليّةِ التأزير ذاتِها؛ لأنّ المؤازرَ ليسَ المؤازَرَ ومع ذلك هما ينزَعانِ لذاتِ الشيءِ، وهذا الشيءُ في العلاقةِ بين المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ وبالمعنىِ الخاصِّ هو نفسُه العلاقةُ بين الموضوعِ والمحمولِ، لكن مع انفرادِ المعرفةِ بالمعنىِ الخاصِّ بالبرهانِ. إذ ما فائدةُ الدليلِ حقًّا كما يقولُ ليبنتز إنْ كانَ الكُلُّ صائِبًا أو ناجِعًا؟[13] إنّ البُرهانَ أو الدليلَ لا معنىَ لهما ولا قيمةَ ما دامت المعرفةُ مأخوذةً بالمعنىِ العامِّ. بصورةٍ عامةٍ فإنّ المعرفةَ بالمعنىِ العامِّ تطابقُ المعرفةَ بالمعنىِ الخاصِّ من خلالِ التأزير أي مدُّها بعلاقةِ الموضوعِ والمحمولِ وتختلِفُ المعرفةُ بالمعنىِ الخاصِّ عن المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ بالبرهانِ.
والصيغةُ الثالثةُ للكوننةِ هي حتمًا سيكولوجيةٌ وإيتيقيّةٌ؛ لأنّه ما دامَت أيُّ كوننةٍ تقومُ بنقلِ المعرفةِ من العامِّ إلى الخاصِّ تتعلّقُ في الأوّلِ والآخرِ بالتجربةِ والجزئيِّ والفردِ، فإنّ الذي يقومُ بدورِ الوسيطِ في ذلك هو الإنسانُ بصفته مَن يقومُ بالبرهنةِ بتوسّطِ الذاكرةِ؛ لأنّ البرهانَ الذي يوفّرُ النقلةَ والتغيّرَ إلى المعرفةِ بالمعنىِ الأخصِّ والذي به تمتازُ عن المعرفةِ بالمعنىِ الأعمّ لا مِناصَّ له من الاحتفاظِ بالسابقِ الذي يمثلُ الماضيَ زمنيًا ليبلغَ اللاحقَ الذي يمثلُ المستقبلَ؛ هنا يظهرُ دورُ الذاكرةِ داخلَ البرهانِ[14]، وعليه فإنّ الذاكرةَ ما دامت ليست يقينيةً بالمطلقِ فإنّ البرهانَ بدورهِ لا يمكنُ أن يكونَ يقينيًا. إنّ النتيجةَ الهامةَ هنا للصيغةِ الثالثةِ للكوننةِ أنّ الاعتقادَ بشيءٍ أو عدمَ الاعتقادِ به لا يمكنُ أن يكونَ مسألةً للإرادةِ لتتخيّرَ فيها[15]؛ لأنّ الذاكرةَ التي يتوسّلُ بها البرهانُ خارجةٌ عن إرادةِ الإنسانِ ونتيجةً لذلك فإنّ البرهانَ يخرجُ بالضرورةِ عن إرادتهِ أيضًا. البشرُ كما يصرّحُ فيلاليث — وقبل أن يستطرِدَ ليبنتز على لسانِ ثيوفيلِ مقِرًّا بما ذهبَ إليه —: «إذا لم يعرِفوا سوى الموضوعَ الفعليَّ لأفكارِهم فإنّهم سيظلونَ جُهَلاء، وذلك الذي سيعرفُ أكثرَ لن يعرف سوى حقيقةٍ واحدةٍ»[16]. إذاً في الصيغةِ الثالثةِ للكوننةِ في إبستمولوجيا ليبنتز ينكشفُ لنا أنّ الجَهالة إنّما هي حصارُ الفعليّةِ لنا دونَ انتقالٍ.
4- المحايَثةُ المُضاعَفةُ، تقاطعُ السردِ القرآنيِّ والابستمولوجيا الليبنتزية:
نبلغُ الآنَ النقطةَ المحوريةَ لهذا التمرينِ الهرمنيوطيقيِّ في المحايَثةِ المُضاعَفةِ، وهي لحظةُ تقاطعٍ بين مجالين مختلفين: الأوّل سرديٌّ قصصيٌّ ينتمي إلى الوحيِ الإلهيِّ، والثاني منطقيٌّ فلسفيٌّ ينتمي إلى معرفةٍ في استطاعةِ الإنسانِ. وقد وضعنا في ترتيبِنا لهذا المبحثِ الجزئيةَ الخاصةَ بالوحي قبل التي تخصُّ المنطق والفلسفة وعلَّةُ ذلِك هامَّة، وغرضها إبانة ما باستطاعةِ الوحيِ قولهُ بالنظرِ إلى غيره لا ما يستطيعُ غيرُه أن يقولَه فيه. وقبل أن نتناولَ هذه النقطة لا بدَّ أن نعدَّ وبصورةٍ بيّنةٍ تعريفَ ما يمكنُ أن تكونَ عليه الجَهالةُ عندَ ليبنتز وما إذا كانت تتقاطعُ مع ما خلصنا إليه في سورةِ يوسف، وعَلينا أن نبحثَ عن دلالاتِ الكوننةِ بدءًا من الأداتية-الاستعماليةِ إلى القانونية-السوسيولوجيةِ حتى السيكولوجية-الإيتيقيةِ التي في سورةِ يوسف والتي تتحددُ على التوالي بنونِ التوكيدِ والجزمِ والنونِ المخففةِ والنونِ العاديةِ التي تدلُّ على فرطِ قابليّةِ الشيءِ وهشاشتهِ تجاه التأثيراتِ والتفاعلاتِ التي تصيبه. وفي علاقتها بصيغِ الكوننةِ التي خلصنا إليها عندَ ليبنتز — أي الكوننةُ كتأزيرٍ والكوننةُ كتطابقٍ واختلافٍ والكوننةُ من خلالِ الذاكرةِ — نحصلُ على المحايَثَ الذي تضاعف. ويتعيّنُ الأمرُ في المحايَثةِ المُضاعَفةِ حينما تأخذُ مسارًا هرمنيوطيقيًا تجاه النصوصِ أن تبدأَ من الاختلافِ لا بصفتهِ مبدأَها بل بصفتهِ مسلَّمةَ الفلسفاتِ تجاه بعضها البعض، ثم تسيرُ نحو وحدةٍ تنتهي نحو الإيمانِ الحَيِّ كشرطٍ مسبَقٍ للجلالةِ. فالإيمانُ تسليمٌ وانقِهارٌ بما لا يُحاطُ به وهو الجليل، وإذا كان كلُّ طرف مِن الثنائياتِ قادر على إصدارِ الآخر فنكون قد تحصّلنا على ما لا يُحاطُ به وتقبَعُ وسطَهُ النفسُ. إنّ ما لهُ الجلالةُ هو القادرُ على إصدارِ نقيضِه وإن كان تامًّا لكنه مع ذلك ينتمي إليه كخلقِ الله -عزَّ وجلَّ- للشيطانِ.
4.1- الصيغةُ الأولىُ للكوننةِ: التضاعفُ الأداتيُّ والمؤازرةُ التأزيرية:
في الفقرةِ الأولىِ والخاصةِ بسورةِ النبيِّ يوسف تحصّلنا على دلالةٍ أوّلَى من خلالِ الآيةِ التي يردُ فيها لفظُ السجنِ بالنونِ الثقيلةِ في صيغةِ «ليُسجَنَنَّ» على لسانِ امرأةِ العزيزِ، وسمّيناها بالدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ؛ لأنّ النونَ الثقيلةَ تفيدُ التوكيدَ والجزمَ والحتميّةَ في النحوِ، وهذه الحتميّةُ مردُّها إلى أنّ امرأةَ العزيزِ هي امرأةٌ تنتمي إلى العزِّ وبلاطِ الملكِ الذي يصرفُ شؤونَ الشعبِ كافةً، فضلًا عن العبيدِ الذين ينتمي إليهم يوسفُ عليهِ السلام. ويجبُ علينا أن ننظرَ أوّلًا في هذه الدلالةِ باعتبارِها الدلالةَ الأعمَّ؛ لأنّ كلَّ دلالاتِ الكوننةِ يحدثُ حدثانُها في نطاقِها من الدلالةِ القانونية-السوسيولوجيةِ والمعبَّرِ عنها بالفعلِ الناقصِ وبالنونِ المخففةِ في قولِها «ليَكُنَّ»، حتى الدلالةَ السيكولوجية-الإيتيقيةِ والمعبَّرِ عنها بفعلٍ ناقصٍ مجزومٍ يفيدُ الدعاءَ والتمنّيَ والرجاءَ بالنونِ الخفيفةِ «أَكُنْ» على لسانِ يوسف عليهِ السلام لئلّا يكونَ منَ الجاهلينَ. إنّ الدلالةَ الأداتية-الاستعماليةَ هي ما تقومُ بالكوننةِ؛ لأنّ الحتميّةَ في النونِ الثقيلةِ في قولِها «ليُسجَنَنَّ» هي تصييرٌ قانوني-سوسيولوجيٌّ نتيجتُهُ الكونُ صاغرًا، وما دامَ هناك حتميّةٌ وغلبةٌ وحصارٌ فهذه جميعُها لا تقعُ إلّا حولَ ما هو قابلٌ لأن يتفاعلَ معها، أي أنّها تشترطُ كينونةً سيكولوجية-إيتيقيةً هشّةً يكونَ الانتصارُ عليها أكيدًا.
يمكنُ الآنَ بالنظرِ إلى الصورةِ النحويةِ التي استخدمها القرآنُ الكريم أن نرى في قولِ امرأةِ العزيزِ «ليُسجَنَنَّ» بالنونِ الثقيلةِ التي تفيدُ التوكيدَ والجزمَ والحتميّةَ أنّ نسبةَ فعلِ التأزيرِ — الذي هو أوّلُ صيغةٍ للكوننةِ الخاصّةِ بالتحديدِ العامِّ للمعرفةِ كعلاقةٍ بينَ موضوعٍ ومحمولٍ — إلى المعنىِ الخاصِّ لها والبُرهانِ المنطقيِّ الهشِّ بقدرِ هشاشةِ الذاكرةِ هي نسبةُ كوننةِ امرأةِ العزيزِ باعتبارِها سيدةً من ساداتِ قومِها إلى مَن تسودُهم. ففي حدودِ ما هو منطقيٍّ فإنّ الخيارينِ المطروحينِ ليوسفَ عليهِ السلام، وهما إمّا السجنُ أو تلبيةُ رغبتِها، كلاهما فعلٌ تأزيريٌّ لقدرتها على الكوننةِ: فهو في السجنِ تحتَ يدِها وخارجَ السجنِ كذلك مع فقدِ إمكانيةِ تلبيةِ رغبتِها منه. وهذه هي الدلالةُ الأداتية-الاستعماليةُ للكوننةِ والتي وجدناها في تحليلِنا لكلمةِ «ليُسجَنَنَّ» بالنونِ الثقيلةِ في سورةِ يوسف، وعندَ ليبنتز فإنَّ حدثانُ يوسفِ عليهِ السلام في إطارِ امرأةِ العزيزِ هو كحدثانِ المعنىِ الأخصِّ للمعرفةِ في إطارِ المعنىِ الأعمِّ، وهما أي الحدثانُ داخلَ إطارِ امرأةِ العزيزِ وحدثانُ المعنىِ الخاصِّ داخلَ العامِّ لهما دلالاتُ الطموحِ والنماءِ والتوسّعِ والازدهارِ والعملِ والفعلِ؛ لأنّ الإنسانَ المتهمَ بما ليسَ فيه ولا يستطيعُ دفعَه كما في سورةِ يوسفِ — والإنسانُ المحاصرُ في فعليّةِ الإدراكِ — لا يملِكانِ إلّا أن يتحوّلا ممّا يحاصرُهما وإن كان بسجنٍ يصاغرُ المسجونَ أو ذاكرةٍ تضعِفُ اليقينَ ليجدا إمكانيّاتٍ للكينونةِ سوى تلك التي يفرِضها المحاصِرُ.
4.2 – الصيغةُ الثانيةُ للكوننةِ: الدلالةُ الأنطولوجيةُ والقانونية-السوسيولوجيةُ والمقارنةُ:
جاءت الدلالةُ الأنطولوجيةُ والقانونية-السوسيولوجيةُ في سورةِ يوسف على لسانِ امرأةِ العزيزِ بصيغةِ النونِ المخففةِ «ليَكُوناً» أي الاحتماليةِ؛ لأنّ السجنَ المحتّمَ عليه ما دامَ يوسفُ بريئًا فهو لن يكونَ فيه صاغرًا مجرمًا إلّا إن كان قد فعلَ فعلَةً تجعله حقيقًا به؛ ثمّ إذاً إنتهاك للحقِّ بيِّن وإسقاط للعدالة واضِح تُجاهه؛ لكن مع تعبیرٍ مخاتِلٍ يعلنُ عن براءةِ من سيسجن عبرَ النّونِ المخفَّفة في «ليَكُوناً» لِيُجعَلَ مِنَ الصَّاغِرين، والتي قَد تفيد عجزَ إمرأة العزيز عن ضمان أن يكونَ صاغِرا فيه. وعليه فإنّ المسجونَ ماهو بالمجرمٍ، بل هو شخصٌ (يوسفُ عليه السّلام) ما عادَ بإمكانِ امرأةِ العزيزِ أن تحدِّدَه. إنّ ما يحدثُ في هذه الدلالةِ في علاقتها بالدلالةِ الأولى الأداتية-الاستعماليةِ أنّ ما هو مستعملٌ وبمثابةِ الأداةِ ما عاد بالإمكانِ أن يتحدّدَ بالشكلِ المرادِ لهِ والمفروضِ عليهِ والوحيدِ المطروحِ أمامَه، ثمّ تمردٌ وندودٌ داخلَ إطارِ الحصارِ بيدَ أنّ هذا النددَ مؤزّرٌ أيضًا من قِبلِ امرأةِ العزيز؛ لأنّه في إطارِ السجنِ أي ما يحدّده ما تكونُه هي باعتبارها سيدةَ البلاطِ. ولنلاحظ الآن علاقةَ المعرفةِ بالمعنىِ الأعمِّ بمعناها الخاصِّ عندَ ليبنتز: فإنّه رغمَ حدثانِ المعنىِ الخاصِّ داخلَ العامِّ وتآزُرهِ به — والذي يعدُّ المعرفةَ علاقةً بينَ موضوعٍ ومحمولٍ — إلّا أنّه لا يمكنُ للمعنىِ العامِّ أن يُقبلَ كما هو داخلَ المعنىِ الخاصِّ وإلّا أصبحا ذاتَ الشيءِ وصارَ المعنىُ الخاصُّ عقيمًا لا يُنتِجُ برهانًا، وصارت أيُّ علاقةٍ غيرَ متميّزةٍ عن الأخرى. فوجودُ شيءٍ ما ومنحهُ صفةً ما لا يخلُقُ حقيقةً خارجةً عن إطارِ القِيَمِ والموضوعِ.
ثمّ إذا انبثقَ معيارٌ أو مِقياسٌ بحسبِه تُحكَمُ العلائقُ حينما ننتقلُ من الدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ إلى الدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجيةِ في سورةِ يوسف، وحينما ننتقلُ من المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ إلى المعرفةِ بالمعنىِ الخاصِّ. وهذا الانبثاقُ للمعياريةِ وظيفتُهُ الأساسيةُ هي إظهارُ الاختلافِ الأنطولوجيِّ أو يمكنُ القولُ أنّه حدٌّ مانعٌ للمطابقةِ من أن تمتدَّ في مستوىٍ لا يمكنها فيه أن تقدّمَ شيئًا. وهذا بينٌ في سورةِ يوسف لمّا قالت امرأةُ العزيز قبلَ الوعيدِ والتهديدِ بالسجنِ «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم» تعبيرًا عن أنّه لم يبادلها الهمَّ بها كما بادَلَته لما انفرَدَتْ به؛ أي لم يطابقها في فعلِها. إذًا لا يمكنُ أن يبقى شيءٌ ليوسفَ في علاقته بامرأةِ العزيز أو للمعرفةِ بالمعنىِ الخاصِّ في علاقتها بالمعنىِ العامِّ للحفاظِ على حدثانِهما سوى أن يكونا ما هما عليه داخلَ الحِصارِ لكن بصيغةٍ مختلفةٍ: لا تطابقٌ وتماثلٌ المحاصِرِ، ولا اختلافٌ كُليٌّ عنهُ لأنّ كلاهما يحدثانِ في إطارِه.
إنّ السجنَ الذي هو وقايةٌ مما تدعو إليه امرأةُ العزيزَ هو خيارٌ مطروحٌ من عندِها ومؤازَرٌ، لكنه أيضًا الخيارُ الذي يحافظُ على الاختلاف؛ لذا لما عبّرَ يوسفُ عليهِ السلامِ قائلاً: «السجنُ أحبُّ إليَّ مِمّا يدعونني إليه» فإنّ الأمرَ قد كان تفضيلاً وليس خيارًا حرًّا تمامًا، لكنّه الخيارُ الذي يمنعُه ويقيه من مماثلةِها في دعوتِها له لنفسِها. فإذاً إنّ انغماسَ في الدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ من قِبلِ يوسفِ باعتبارِه عبدًا ثم ابتعادُه في الوقتِ نفسه عنها بالنظرِ لالتزامِه بعدمِ الوقوعِ في الفحشاءِ — إنّ انغماسَ الدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجيةِ في الدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ هو المطابقةُ والاختلافُ في ذاتِ اللحظةِ. نعني أنّ حدثَ السجنِ والذي هو حدثٌ قانوني-سوسيولوجيٌّ هو مطابقةٌ للدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ من جهةٍ أنّ الفردَ لا يستطيعُ أمامَ الحاكمِ شيءً، وهو في ذاتِ اللحظةِ في حالةِ كانَ المسجونُ بريئًا يُحدثُ اختلافًا بجعلِ السجانِ ظالمًا، لكنّه أيضًا الطريقةُ الوحيدةُ للحفاظِ على الاختلافِ لأنّ خارجَ السجنِ ستحدثُ مطابقةٌ تامّةٌ مع المحاصِرِ وستتحددُ به إمكانياتُ كينونةِ المحاصرِ الذي هو الجَهالة. وإنّ هذه هي العلاقةُ عينها بينَ المعرفةِ بالمعنىِ العامِ والمعنىِ الخاصِّ عندَ ليبنتز بعيدًا عن المسألةِ الأخلاقيةِ والحكميّةِ والمواعظيةِ في سورةِ يوسف، فتأزيرُ المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ للمعنىِ الخاصِّ من خلال علاقةِ الموضوعِ والمحمولِ هو الخيارُ الوحيدُ لتكونَ متميِّزةً عنها أي من خلالِ التطابق؛ نعم هي يمكنها أن تستقلَّ لكن تستقلُّ في إطارِ ما هو محدد لها أي في إطارِ علاقةِ الموضوعِ والمحمولِ.
إذاً فإنّ علاقةَ الدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ المعبَّرِ عنها بالنونِ الثقيلةِ على لسانِ امرأةِ العزيزِ في قولِها «ليُسجَنَنَّ» بالدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجيةِ والمعبَّرِ عنها بالنونِ المخففةِ في قولِها «ليَكُوناً» هي علاقةُ المقارنةِ وما تتضمّنهُ من مطابقةٍ واختلافٍ بين المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ والمعرفةِ بالمعنىِ الخاصِّ. حدثانُ الدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجيةِ باستقلالٍ عن الدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ هو حدثانُ المعرفةِ بالمعنىِ الأخصِّ باستقلالٍ عن معناها العامِّ. وبالمجملِ فإنّ علاقةَ الدلالتينِ في النونِ الثقيلةِ والخفيفةِ في سورةِ يوسف هي علاقةُ المقارنةِ بما تتضمّنهُ من مطابقةٍ واختلافٍ عندَ ليبنتز.
لا بدَّ لنا أن ننتبهَ إلى أنّ النونَ الخفيفةَ في الصيغةِ الثانيةِ للكوننةِ — أو الدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجيةِ في سورةِ يوسف — والانتقالُ والتغيّرُ من المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ إلى المعنىِ الخاصِّ المتوسِّلِ بالبرهانِ هو من حيثُ يبرزُ تباعدًا واختلافًا فإنّه يعبرُ في الوقتِ نفسه عن إضعافٍلصيغِ الكوننةِ الأولى، أي الدلالةَ الأداتية-الاستعماليةَ والمؤازرةَ التأزيريةَ في إبستمولوجيا ليبنتز. إنّ الإضعافَ للصيغِ الأولى هو شرطُ إمكانِ الكوننةِ ويجري الأمر كما لو أنّ هذه الصيغَ الأولى مدٌّ بحرٍ يغطّي جزءًا من الأرضِ؛ لو أنّه تعدّاه لما صار بالإمكانِ التمييزُ بينها وبين باطنِ البحرِ، وسنقول حينها أنّ الأرضَ توجدُ في البحرِ لا أنّ البحرَ يوجدُ في الأرضِ. على وجهِ الدقّةِ فنحن نقصِدُ أنّ قولَ امرأةِ العزيز الذي يعبرُ عن علاقتها بمن هم تحتَ إمرتِها والمعبَّرِ عنه بقولِها «ليُسجَنَنَّ» إنما يُخفّفُ بقولِها «ليَكُوناً» وعليه فإنّ نفاذ أمر إمرأةِ العزيزِ ليس تامّا وبذلِك لن يكونَ مِنَ الضَّرورِي أن يكون يوسُف عليهِ السّلام مِن الصّاغِرين؛ فهو لن يتماهى مَع إرادتها تماما ولن يُخالِفها تماما (علاقة تطابق واختلاف)، وعلاقةَ التأزير بينَ المعرفةِ بالمعنىِ العامِّ والمعنىِ الخاصِّ إنما تُخفَّفُ بعلاقةِ المقارنة وما تتضمنهُ من تطابقٍ واختلاف.
4.3 – الصيغةُ الثالثةُ للكوننةِ: الدلالةُ الأنثروبولوجيةُ والبرهانُ التذكُّريُّ:
إنّ الإضعافَ الذي يحدثُ لصيغِ الكوننةِ الأولى في سورةِ يوسف وإبستمولوجيا ليبنتز إنّما يبلغُ ذروتَهُ عندَ تمامِ التحوّلِ والانتقالِ، وعلى وجهِ التحديدِ عندما ينتقلُ القرآنُ الكريمُ من السردِ على لسانِ امرأةِ العزيز إلى لسانِ يوسف. وبالنظرِ لإبستمولوجيا ليبنتز فإنّ الإضعافَ يحدثُ عندما تعملُ المعرفةُ بالمعنىِ الخاصِّ بما هو مميّزٌ لها أي البرهانُ المعتمدُ على الذاكرةِ الخارجةِ عن يدِ الإنسانِ. وبصورةٍ عامةٍ فإنّ الإضعافَ المتواصلَ لصيغِ الكوننةِ بطريقةٍ متواليةٍ هو صيرورةُ نزوعٍ لتفعيلِ التمايُزِ والاختلافِ. إنّ صيرورةَ الكوننةِ المُنحدرةِ انحدارًا حتى الأبعادِ الأنثروبولوجيةِ والسيكولوجيةِ والإيتيقيةِ هي صيرورةٌ تنحدرُ نحو الإمكانياتِ المباشرةِ للعيشِ.
عُبِّر عنِ الدلالةِ الأنثروبولوجيةِ والسيكولوجيةِ أو الصيغةِ الثالثةِ للكوننةِ في القرآنِ الكريمِ على لسانِ يوسفِ عليهِ السلامِ بقولهِ «أَكُنْ». وإذا نظرنا إلى علاقةِ هذه الصيغةِ التعبيريةِ بالنونِ الثقيلةِ في الدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ — والتي عُبِّرتْ عنها بــ«ليُسجَنَنَّ» — فإنّنا نجدُ في الدلالةِ الأنثروبولوجيةِ والسيكولوجيةِ أثرَ الحتميّةِ الخاصِّ بالدلالةِ الأداتية-الاستعماليةِ. إنّ الإضعافَ المتواليَّ والمتدرِّجَ في دلالاتِ الكوننةِ الخاصّةِ بسورةِ يوسفٍ هو أيضا تعبيرٌ عن إمتداد حضورُ لصيغةِ الكوننةِ الأولى الأداتية-الاستعمالية؛ لأنّ تفضيلَ السجنِ أو البقاءَ في القصرِ لا يخرُجُ كلاهما عن كونهما تعبيرًا عن هذه الصيغةِ الأولى للكوننة ؛ فكلاهما رضوخ لرغبة إمرأة العزيز، إلّا أنّ توَسُّطَ الدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجيةِ هو ما يجعلُ من هذا الحضورِ الممتدِّ حتى الدلالةِ الأخيرةِ للكوننةِ الأنثروبولوجيةِ والسيكولوجيةِ ليسَ حضورًا للشيءِ نفسه؛ لأنّها دلالةٌ تُقِرُّ بالمطابقةِ مع الدلالةِ الأداتية-الاستعمالية إذ أنّ يوسفًا عليهِ السلام هو مخيّرٌ بينَ خيارينِ كلاهما محدَّدٌ من قبلِ هذه الدلالة، ولأنّها دلالةٌ تُقِرُّ بالاختلافِ من حيث أنّ الخيارَ الذي تمَّ تفضيلُه من قبله وهو السجنُ هو الخيارُ الذي يمنعُ المطابقةَ التامّةَ مع الخيارِ الأوّلِ المعبَّرِ عنه بقولِ امرأةِ العزيز «لئن لم يفعلْ ما آمره».
وفي شأنِ الصيغةِ الثالثةِ للكوننةِ أي البرهانِ التذكُّريِّ عندَ ليبنتز يجبُ أن نبدأَ من مُشتَركٍ واضحٍ بينها وبين الصيغةِ التي تنتمي لسورةِ يوسف، وهو أنّ هذه الصيغةَ تقعُ داخلَ خياراتٍ ليستْ من طرحِها الخاصِّ؛ مثلما أنّ يوسفَ لم يكُن أمامَهُ إلّا فعلٌ ما أُمرَ به أي مطابقةُ المحاصِرِ أو السجنُ، فكذلك المعرفةُ بالمعنىِ الخاصِّ: إمّا أن تكونَ متمهِّيةً مع المعنىِ العامِّ فتُقِرّ بعلاقاتٍ بينَ الموضوعِ والمحمولِ متساويةٍ في القيمةِ وكُلُّها تعبيرٌ عن الحقيقةِ، وإمّا أن تضحّي باليقينِ وتستقلَّ معتمدةً على البرهانِ المعتمدِ على ذاكرةٍ ليست تحتَ حكمِ صاحبِها، أو — فلنقل — أن الخيارينِ هما إما الجَهالةُ وإما سعيٌ يرجو قرارًا دونَ ضمانةٍ على بلوغِه.
إنّ الصيغةَ الثالثةَ للكوننةِ أي البرهانَ التذكُّري تنتهي إلى العملِ بالصِيغةِ الأولى للكوننة لكن خارجَ نفسِها؛ بمعنى أنّ علاقةَ الموضوعِ والمحمولِ يُعمَلُ بها خارجَ نطاقِ المعرفةِ بالمعنىِ الأعمِّ ومع إضافةِ البرهانِ إليها. فالتأزيرُ المفعمُ للمعرفةِ بالمعنىِ الخاصِّ من طرفِ معناها العامُّ يقوّمُها دون أن يحددَها كليةً؛ لأنّ البرهانَ يتضمنُ في نفسه مشاركةَ السابقِ الذي هو المبدأُ أو المقدّمةُ في اللاحقِ أي النتيجةَ والمحصلةَ؛ فلو أنّ السابقَ لم يكن يشاركُ أو يؤزّرُ اللاحقَ لكان البرهانُ ممتنعًا، ولو أنّ السابقَ كان هو عينُه اللاحقُ لما كان ثمَّ فرقٌ بين معرفةٍ بالمعنىِ العامِّ ومعرفةٍ بالمعنىِ الخاصِّ. وبما أنّ صيغةَ الكوننةِ الأولى التأزيرية متضمّنةٌ في الصيغةِ الثالثةِ لها أي التذكّريّةُ البرهانية، فإنّ هذه لابدَّ أن تطابقها وتخالفها في الوقتِ نفسه: فهي تمتدُّ داخلها إلى حدِّ منحها علاقةَ الموضوعِ والمحمولِ، وبهذا تتطابقُ الصيغتانِ بتوسيطِ الصيغةِ الثانيةِ للكوننةِ أي المقارنةَ وجانبِ المطابقةِ فيها، وهما تختلِفان بجانبِ الاختلافِ فيهما من جهةٍ أنّ الصيغةَ الثانيةَ التذكريّةُ البرهانيةُ لا تُقرُّ أيّ علاقةٍ بينَ الموضوعِ والمحمولِ كيفما كانت، وبذلك هي خروجٌ من الجَهالةِ باعتبارها حصارَ الوعيِ والإدراكِ المباشرِ بالفعليّةِ أي عدمِ الانتقالِ.
إنّ تعيينَ اختلافِ يوسفِ عليهِ السلام عن امرأةِ العزيز إنما هو بتوسيطِ الصيغةِ الثانيةِ للكوننةِ في سورةِ يوسف أي الدلالةِ الأنطولوجيةِ والقانونية-السوسيولوجية، وتعيينُ اختلافِ المعرفةِ بالمعنىِ الخاصِّ عن معناها العامِّ هو بتوسيطِ الصيغةِ الثانيةِ للكوننةِ أي المقارنةَ. وتضمّنُ الصيغتينِ الثانيتينِ في كلٍّ من سورةِ يوسف وإبستمولوجيا ليبنتز دلالةَ العدلِ والملكيةِ بأوسعِ معانيهما؛ لأنّ العدلَ كإعطاءِ كلِّ شيءٍ حقَّهُ يحافظُ على ما يعودُ للشيءِ الواحدِ وما لا يعودُ إليه، أي أنّه الإمدادُ بالتطابقِ والاختلافِ.
5 – خلاصةُ المحايَثةِ المُضاعَفةِ في الصبوةِ إلى الجَهالةِ في سورة يوسف وإبيستمولوجيا ليبنتز:
إنّ خلاصةَ صيغِ الكوننةِ كافةً في سورةِ يوسف وإبستمولوجيا ليبنتز هي الانعتاقُ من الصيغِ الأولى لها، أي الدلالةُ الأداتية-الاستعماليةُ والتحديدُ الأعمُّ للمعرفة. تبدأُ صيرورةُ الانعتاقِ هذه في سورةِ يوسف بتحللٍ نونيٍّ من النونِ الثقيلةِ إلى المخففةِ حتى الخفيفةِ، أمّا في إبستمولوجيا ليبنتز فهو تحلّلٌ لعلاقةِ التأزيرِ من المعنىِ الأعمِّ إلى المعنىِ الخاصِّ. وقد بينّا علاقةَ كلِّ صيغةٍ من صيغِ الكوننة في السياقِ السرديِّ الشعريِّ الدينيِّ والقرآنيِّ بصيغِها في إبستمولوجيا ليبنتز، وهذا كافٍ لبيانِ كيفَ يمكنُ للسرديِّ أن يكونَ في الفلسفيِّ المنطقيِّ وكيفَ يمكنُ للفلسفيِّ المنطقيِّ أن يكونَ في السرديِّ، وبالمجملِ كيفَ يمكنُ لبنيةِ الخطاباتِ المتناقضةِ أن يتكوّرَ كلُّ واحدٍ منها داخلَ الآخر.
وهذا التكوّرُ المتبادلُ هو لبُّ حدثانِ المحايَثةِ المُضاعَفةِ؛ لأنّها تُعنى بالكيفيةِ التي بحسبِها يمكنُ للشيءِ الواحدِ في رجوعِه إلى نفسهِ وكونِه هويةً متطابقةً مع نفسها أن يُصدِرَ آخرَ مختلفًا عنه لكنه مع ذلك غيرٌ وحالٌ من أحوالِه ومنتمٍ إليه. وفي شأنِ القرآن الكريمِ بالذاتِ فهي تضعُ نصبَ عينَها الآيةَ القرآنيةَ 38 من سورةِ الأنعامِ القائلةِ: «ما فرّطنا في الكتابِ من شيءٍ» كزعمٍ يبقى معتبرًا وعهدًا لابدَّ أن يُجدَّدَ كلَّ حينٍ.
قائمة المراجع:
1- ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ (فاس-المغرب: دارُ الثقافة للنشرِ والتوزيع، ترجمةُ د. أحمد فؤاد كامل، 1983).
2- إيمانويل كانط، نقدُ العقلِ المحضِ (بيروت-لبنان: المنظمةُ العربيةُ للترجمة، ترجمةُ غانمِ حنّا، ط1، 2013).
3-ويلارد فان أورمان كواين، تسعُ مقالاتٍ منطقيةٍ فلسفيةٍ (بيروت-لبنان: المنظمةُ العربيةُ للترجمة، ترجمةُ د. حيدر حاج علي إسماعيل، ط1، 2006).
4-غوتفريد فيلهلم ليبنتز، المونادولوجيا (بيروت-لبنان: المنظمةُ العربيةُ للترجمة، ترجمةُ ألبر نصري نادر، ط1، 2015).
[1] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ (فاس-المغرب: دارُ الثقافة للنشرِ والتوزيع، ترجمةُ د. أحمد فؤاد كامل، 1983)، ص. 133.
[2] إيمانويل كانط، نقدُ العقلِ المحضِ (بيروت-لبنان: المنظمةُ العربيةُ للترجمة، ترجمةُ غانمِ حنّا، ط1، 2013)، ص. 130.
[3] – ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 131.
[4] ويلارد فان أورمان كواين، تسعُ مقالاتٍ منطقيةٍ فلسفيةٍ (بيروت-لبنان: المنظمةُ العربيةُ للترجمة، ترجمةُ د. حيدر حاج علي إسماعيل، ط1، 2006)، ص. 54.
[5] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 131.
[6] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 133.
[7] نفسه.
[8] غوتفريد فيلهلم ليبنتز، المونادولوجيا (بيروت-لبنان: المنظمةُ العربيةُ للترجمة، ترجمةُ ألبر نصري نادر، ط1، 2015)، ص. 51.
[9] غوتفريد فيلهلم ليبنتز، المونادولوجيا،مرجعٌ سابق، ص. 54.
[10] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 134.
[11] نفسه.
[12] نفسه.
[13] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 135.
[14] نفسه.
[15] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 135.
[16] ج.ف. ليبنتز، أبحاثٌ جديدةٌ في الفهمِ الإنسانيِّ، مرجعٌ سابق، ص. 135.