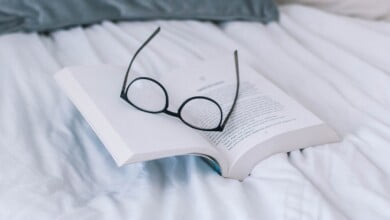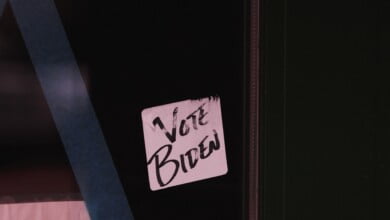محمد بن سالم بن علي جابر
في ذاكرة الحضارم، الهجرة ليست نكبة تسردها المآسي، ولا قطيعة ترويها كتب الشتات، بل رحلة مفتوحة على الأفق، يتعاقب فيها الذهاب والإياب، وتظل فيها حضرموت حاضرة في القلب وإن غابت عن العين. وعلى مدى قرون، ظل الحضرمي يتحرك في فضاءات المحيط الهندي وشرق أفريقيا وآسيا، حاملاً معه لغته وثقافته ونظامه الاجتماعي، ومحتفظًا في الوقت نفسه بروابطه القوية بأرضه الأولى.
ومع ذلك، برز في السنوات الأخيرة من يصف هذه التجربة التاريخية العريقة بمصطلح “الشتات”، محملاً إياها ما ارتبط به في الوجدان العربي من معاني الفقد القسري والانقطاع الأبدي عن الوطن. هذه المقاربة تستدعي مراجعة، ليس إنكارًا لوجود أوجه شبه في بعض المظاهر، بل لأن خصوصية الهجرة الحضرمية قد تجعل هذا الوصف قاصرًا عن الإحاطة بجوهر التجربة.
الإشكالية: بين القالب الجاهز والخصوصية التاريخية
عند تناول الهجرة الحضرمية في الدراسات الاجتماعية والتاريخية، يصبح السؤال المطروح: هل يصح إدراجها ضمن مفهوم الشتات كما هو معروف في التجارب التاريخية الكبرى، مثل الشتات الفلسطيني أو الأرمني؟ أم أن الأمر يتطلب قراءة أكثر مرونة، تراعي أن الحضارم كانوا – في غالب الأحوال – يسافرون بخيارهم، وأن رحلتهم إلى الخارج كثيرًا ما كانت نقطة في دائرة، تتصل بخط رجعة نحو حضرموت؟
الشتات، في تعريفه الأكاديمي، يقوم على فقدان شبه كامل للصلة الجغرافية والنفسية بالوطن الأم، غالبًا نتيجة اقتلاع قسري أو ظروف تمنع العودة بشكل حقيقي أو رمزي. أما الهجرة فتتسم بمرونة أكبر، وبإمكانية تكرار الانتقال والعودة، سواء أكانت الدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو دينية. ومن هنا، يصبح وضع “الهجرة الحضرمية” في خانة الشتات قضية إشكالية، إذا أهملنا الفروق الجوهرية.
دوافع الهجرة الحضرمية عبر التاريخ
الهجرة الحضرمية ليست وليدة القرن العشرين، بل جذورها ضاربة في عمق القرون الماضية. فقد رافقت ازدهار التجارة عبر المحيط الهندي، حيث أسس الحضارم شبكات تجارية واسعة امتدت إلى الهند وماليزيا وإندونيسيا وسواحل أفريقيا الشرقية. كانت بعض الهجرات بدوافع البحث عن الرزق أو توسعة النشاط التجاري، بينما جاءت هجرات أخرى استجابةً لتحولات سياسية أو هربًا من ثارات قبلية أو شظف عيش أو حتى بفعل كوارث طبيعية مثل الجفاف والمجاعات.
ومع ذلك، يظل القاسم المشترك أن معظم هذه الرحلات لم تكن مقرونة بقطع الأمل في العودة. فالمهاجر كان يسافر وعيونه معلقة بوطنه، محتفظًا بروابط أسرية وأملاك أو أراضٍ أو بيت في حضرموت، وكثيرًا ما كان يعود بعد سنوات حاملاً ما جناه من خبرة وأموال، أو يعود نهائيًا ليستقر من جديد.
الهجرة الحضرمية: جسور لا قطيعة
تميزت الهجرة الحضرمية بكونها تفاعلية ثنائية الاتجاه. فكما كانت قوافل الحضارم تغادر، كانت أخرى تعود، حاملة معها منتجات وأساليب حياة وتأثيرات ثقافية من بلاد المهجر. في بعض المدن الحضرمية، يمكنك حتى اليوم ملاحظة الطراز المعماري المتأثر ببيوت زنجبار أو جاوة، أو سماع ألفاظ دخلت اللهجة المحلية نتيجة للاحتكاك الثقافي.
هذا التبادل المستمر أوجد فضاءً حضرمياً عابرًا للحدود، حيث يمكن للحضرمي أن يكون جزءًا من شبكة اجتماعية واقتصادية وثقافية ممتدة من تريم وسيئون والمكلا إلى كوالالمبور وسورابايا وممباسا وعدن. هذه الشبكات قدرت على ربط المهاجر بوطنه الأم حتى في زمن غياب وسائل الاتصال الحديثة.
هوية حافظت على تماسكها
من أبرز سمات الهجرة الحضرمية حفاظ المهاجرين على منظومة هوية متينة، تقوم على العصبية الأسرية والنسب والولاية الدينية، أكثر من اعتمادها على اللغة أو الجنسية. ولهذا لم يكن الاندماج في المجتمعات المضيفة على حساب الهوية، بل امتزج الانفتاح مع الحفاظ على الخصوصية. فقد أنشأ الحضارم مساجد ومدارس وأوقافًا، وأداروا روابط أهلية ظلت تحمل اسم حضرموت وتخدم أبناءها في المهجر.
حتى الأجيال الثانية والثالثة – التي وُلدت في الخارج – ظل كثير منها يحتفظ بارتباط وجداني واضح بحضرموت، ويتوق لزيارتها أو المشاركة في مشاريعها. وهذا يختلف عن أوضاع الشتات الكلاسيكي، حيث تنقطع الأجيال الجديدة عن الوطن الأم لافتقاد الصلة الحية به.
التحفظ على مصطلح “الشتات“
لا يمكن إنكار أن بعض العوامل التي دفعت للهجرة الحضرمية يمكن وصفها بالقسرية غير المباشرة، مثل الفقر أو انعدام الأمن أو ضعف فرص العمل. لكن الفارق الجوهري يكمن في أن هذه الظروف لم تتحول إلى اقتلاع كامل يمنع العودة، بل ظلت العودة خيارًا واقعيًا ومتحققًا في كثير من الحالات.
التعميم باستخدام مصطلح “الشتات” يجعلنا نتجاهل هذه الفروق، ونتبنى قالبًا دلاليًا يضمر الإكراه والانقطاع الأبدي، وهو ما قد يسيء توصيف الظاهرة. فالتجربة الحضرمية أقرب إلى “الهجرة العالمية” أو “الهجرة التفاعلية”، حيث يتداخل البعد الاقتصادي مع الديني والاجتماعي، وتتصل حركة الأفراد بخياراتهم الشخصية بقدر ما تتأثر بالظروف.
البعد النفسي والاجتماعي للهجرة الحضرمية
الحضرمي في المهجر – حتى حين تطول غربته – لا يعيش الاغتراب كحالة نهائية. الغربة هنا غالبًا شعور مرحلي، مشوب بوعي بأن الوطن الأم موجود ويمكن الوصول إليه، وبأن ثمة جذورًا يمكن العودة إليها في أي وقت. هذه الحالة النفسية تختلف جذريًا عن الحالة الشعورية في الشتات، الذي يترسخ فيه إحساس الفقد واللاعودة جيلاً بعد جيل.
حضور حضرمي عالمي وأثر حضاري
في أي مكان وصل إليه الحضارم، تركوا بصمات واضحة: ازدهرت التجارة، وانتشرت أنماط عمران جديدة، وأسهموا في نشر العلوم والمعارف والنشاط الدعوي. في إندونيسيا، لعبوا دورًا مهمًا في الحركات الوطنية، وفي شرق أفريقيا كان لهم تأثير اقتصادي بارز. كل ذلك تم دون أن يفقدوا شعورهم بالانتماء لحضرموت، أو أن يقطعوا حبال الاتصال بها.
خاتمة
إن التجربة الحضرمية، في جوهرها، ليست شتاتًا بالمعنى الذي يوحي بالانقطاع الإجباري أو الفقد الأبدي، بل هي نموذج فريد من الهجرة التفاعلية المتصلة زمنيًا وثقافيًا بوطنها الأصلي. لقد جمعت بين الانفتاح على العالم وحفظ الهوية، وبين بناء الجسور مع الآخر وصيانة الروابط مع الجذور.
ولعل أدق توصيف لهذه الظاهرة هو “الهجرة الحضرمية العالمية” أو “الهجرة الحضرمية التفاعلية”، بما يعكس واقعها التاريخي وفرادتها الاجتماعية، ويجنّبها أن تُحشر في قوالب الشتات الثقيلة التي لا تعبر عن حقيقتها. إن هذا التوصيف لا يحمي دقة البحث الأكاديمي فحسب، بل يصون أيضًا المعنى الإيجابي للهجرة في الذاكرة الحضرمية، باعتبارها فعل اختيار ومسار تواصل، لا حكاية فقد وانقطاع.
خلاصة القول:
- الهجرة الحضرمية ليست قصة فقدان قسري أو انقطاع نهائي، بل هي حركة اختيارية متجددة بين الوطن والمهجر.
- مصطلح “الشتات” يحمل دلالات ثقيلة مرتبطة بالاقتلاع القسري وعدم إمكانية العودة، وهو غير دقيق لوصف التجربة الحضرمية.
- التجربة الحضرمية تتميز بمرونة في التنقل، مع استمرار التواصل العائلي، الثقافي، والاجتماعي مع المجتمع الأصلي.
- حضرموت تبقى حاضرة في هوية المهاجرين الحضارم، حتى في أجيال الخارج، عبر الحفاظ على اللغة، العادات، وروابط النسب.
- الهجرة الحضرمية عبر التاريخ كانت نتيجة دوافع اقتصادية، اجتماعية، دينية، وبعضها قسرية غير مباشرة، لكنها لم تمنع الفرصة للعودة.
- الهجرة الحضرمية ليست انتصارًا للانغلاق أو الذوبان، بل مثال للتوازن بين الاندماج مع الحفاظ على الهوية.
- الحضارم تركوا أثرًا حضاريًا واضحًا في مناطق الهجرة عبر التجارة، البناء الثقافي، والنشاط الديني والسياسي.
- وصف الهجرة الحضرمية بأنها “الهجرة العالمية” أو “التفاعلية” أكثر دقة ومصداقية من وصفها بالشتات.
- البعد النفسي للهجرة الحضرمية يتسم بشعور مؤقت بالغربة، مع وعي مستمر بوجود الوطن وفتح أبواب العودة.
- فهم خصوصية الهجرة الحضرمية يساعد في تجنب التعميمات الخاطئة التي تخفي التعقيد والتنوع في تجارب المهاجرين.