- تأليف : يوسف سمرين
- تحرير : ناريمان علاء الدين
لما يجري الحديث عن (علم الكلام)، فإنه كثيرًا ما يتوجه الفهم لدلالته باعتبار ما تم إنتاجه من تعريفات رسمية له، ومن ذلك اعتبار أنه: حجاج عقلي عن العقائد الإيمانية كما يرى ابن خلدون[1]، لكن هذا التعريف رسمي مدرسي، أو بعبارة أخرى: هو ما أرد المتكلمون من خلاله أن يُظهروا ما يقومون به لغيرهم، إلا أن هذا يقفز عن الوقائع داخل التاريخ الذي تبلور فيه مصطلح (الكلام).
إن هذا التعريف الرسمي لم يكن محل تسليم بين أهل الحديث، ولا الفلاسفة على السواء، ولذا فقد انهمك ابن رشد في بيان أن طوائف المتكلمين “اعتقدت في الله اعتقادات مختلفة، وصرفت كثيرًا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوها على تلك الاعتقادات … وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع، ظهر أن جلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة”[2]، فليس الكلام منفصلًا عن نحت وتشكيل الاعتقادات في الله، كما حاول التعريف الرسمي أن يصوّر الأمر؛ بأن الكلام مجرد دفاعٍ عن العقائد الإيمانية التي يصوَّرها كأنها مستقلة عن منظوماتهم التي سوّق لها بحجة الدفاع عن العقائد، وكأنه لا يزاحم علومًا شرعية عديدة: من علم الحديث، قواعد التفسير وأصول الفقه في بيان معاني النصوص العقدية، إنما هو علم يدافع عما يقرره هؤلاء العلماء من العقائد، لكن بحججٍ عقلية، في تجاهل لما كانت المنظومات الكلامية تقوم به من تأويل العديد من ظواهر الشريعة، ليتسق مع مقالاتها المحدثة.
مثال ذلك القول بأن القرآن مخلوق كما قالت المعتزلة، أو ابتكار قسم يجمع بين قول المعتزلة وخصومهم من أهل الحديث، بالقول بأن القرآن قسمان: لفظي وهو الذي المتلو المحفوظ، فهذا مخلوق، أو هو معنى قائم في الذات، لا تفريق فيه بين خبر وأمر، ولا إنشاء وإخبار، وهو قديم غير مخلوق، كما قالت الأشعرية.
إن منظومات الكلام كانت كما قال ابن رشد بحق تندرج تحت “صناعة الجدل”[3]، فكانت مجموعة مقالات ترد على الإلزامات لفرق مخالفة لها، وتلتزم بعض الأصول التي تتسق-بنظرها-مع مقالاتها في العقائد، فمنظومة الكلام يمكن اختصارها بأنها: إلزام والتزام، وليست منظومة معرفية تؤدي إلى الوصول إلى الحقائق، إنما غايتها التشغيب على الخصوم، وإلزامهم المقالات الشنيعة، والانفصال عن إلزاماتهم للفرقة الكلامية التي تدافع عن نفسها.
وفي هذا الإطار قال أبو حامد الغزالي:
“قد يُظن أن فائدته [عنى علم الكلام] كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدِّث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة، وبعد التغلل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أُخر تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود”[4].
كانت هذه الطريق في مقالاتها لا تنطلق من تحقيق (نظرية المعرفة) بل تحاول تجاوز المشكلات النظرية التي لا تتعلق بمقالاتها، إلى النتائج التي يمكنهم عن طريقها (الجدل) بإلزام الخصوم وإفحامهم، ومثال ذلك ما قام به الملاحمي من المعتزلة، حين عرّف المعرفة الضرورية بقوله: “إن الضروري هو علم لا يقف على استدلال العالِم به، إذا كان يصح فيه الاستدلال”[5]، فالمهم أن ينطلق من معرفة ضرورية يبني عليها كلامه اللاحق المنتصر للمعتزلة، بقطع النظر عن كل البحوث التي ستحدد طبيعة تلك المعرفة وتبحث في مصدرها، وعلاقتها بغيرها، فرأى أن هذا التعريف سيتفق عليه الجميع حتى ولو كانت نظرتهم إلى الضرورة العقلية مختلفة، فقال: “يستمر هذا الحد على قول من يقول:
1. إن العلوم الضرورية مفعولة في العاقل.
2. أو قيل: إنها موجبة فيه.
3. أو قيل في بعضها: إنه مفعول مبتدأ فيه، وفي بعضها: إنه موجب عن الإحساس أو نحوه”[6].
فبقطع النظر عن كل هذه الأقوال، يعنيه أن يتم تعريفها بما قال به، والانطلاق من هذا التعريف في الحِجاج الجدلي مع غيره من الطوائف والفرق، وهذا كان على حساب التحقيق في البحوث المتعلقة بنظرية المعرفة في المقام الأول، ولذا فإن “المعتزلة والأشاعرة والصوفية لم يكن لهم بحث في المعرفة سوى مسائل متفرقة كمقدمات وتمهيدات للنظريات التي قدموها”[7].
وهذا جعل الغفلة ملازمة للمتكلمين عن الاتساق الداخلي، إن تجاوز تلك المباحث كان في الظاهر يقوّي الأطروحات الجدلية، ويزيد من أثر الحجج الخطابية لكل فرقة، لكنه في الواقع كان يضعف القوة النظرية لمباحثها، ومثال ذلك: أن الأشعري الذي كان قد سلّم بأن الله لا يشار إليه، يقول بأنه يُرى يوم القيامة، لكن دون جهة، وهذا قد اضطره ليوضح ما المقصود بالرؤية عنده-إذ لم يكن عنده فيها أي مدخلات حسية في العين-لكنه بدل هذا التوضيح، كان يحاول القفز عن نفس المشكلة مرارًا، فالمشكلة النظرية ليست هي الرئيسية في الكلام الأشعري، بل يأتي في المقام الأول إفحام المعتزلة الذين نفوا الرؤية، على أنهم مقصده الرئيسي.
ولذا كان يتحدث في هذا الإطار، بأن “الحس هو العلم بالمحسوس”[8]، دون وجه العلاقة بين الحس والعلم، دون حتى توضيح للمقصود عنده بالعلم، والحس، فما هو العلم وبماذا يختلف عن الحس؟ يقول في العلم: “ما به يعلم العالِم المعلوم”[9]، فهو يعرف الشيء بما هو مشتق منه، العلم العالم المعلوم! ليصل إلى مشكلة هل الرؤية التي يثبتها علم أم هي حس؟ ليقول: “الرؤية علم بالمرئي”[10]، فهي علم، لكن ليس وعياَ مجردًا صرفًا فسرعان ما ذكر المرئي، ولكنه قفز عن تحديد: الرؤية نفسها، فذكر العلم، وذكر المرئي، دون بيان موقع الرؤية نفسها، وما هي وما طبيعتها، وما علاقتها، كوسط بين العلم وبين الموضوع (المرئي) وبهذه الحلول اللفظية كان يتم سحق المباحث في نظرية المعرفة، وبالتالي لا تقدر على النهوض أمام أي فلسفة متسقة، بقطع النظر عن صحتها.
إن إشكالات الكلام على الصعيد النظري عديدة، لكن فيما يخص المباحث الفلسفية، كان أهمها:
1. الانحصار في الإلزام والالتزام، بالجدل، مما يجعل البحوث مهتمة بالإفحام إلى حدود المماحكات اللفظية، لا التأسيس لمنهج نظري لمعرفة الحقائق.
2. القفز عن تاريخ الكلام نفسه، والبحث في تاريخ المقالات المتشكلة فيه من باطن التاريخ، لا التعالي عليه كمقولات مجردة.
3. تجاهل الكثير من البحوث النظرية بوصفها غير خادمة لطريقة الحِجاج التي اصطبغ بها الكلام، مما زاد الغفلة عن ضرورة الاتساق الداخلي في المذاهب الكلامية.
[1] انظر: تاريخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، ضبط المتن: خليل شحادة، دار الفكر، بيروت-لبنان، 2001، ج1 “المقدمة”، ص 550.
[2] مناهج الأدلة عن عقائد الملّة، ابن رشد، تحقيق: محمود قاسم، مكتبة الإنجلو مصرية، 1964م، ص134.
[3] مناهج الأدلة عن عقائد الملّة، ابن رشد، ص139.
[4] قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، عالم الكتب، بيروت-لبنان، الطبعة الثانية: 1405هـ-1985م، ص101.
[5] المعتمد في أصول الدين، محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي، تحقيق: مارتن مكدرمت، ويلفرد ماديلونغ، الهدى-لندن، 1991م، ص22.
[6] المعتمد في أصول الدين، محمود بن محمد الملاحمي الخوارزمي، ص22.
[7] نظرية المعرفة عند مفكري الإسلام وفلاسفة الغرب المعاصرين، محمود زيدان، مكتبة المتنبي، الدمام-المملكة العربية السعودية، 1433هـ-2012م، ص222.
[8] مقالات أبي الحسن الأشعري، محمد بن الحسن بن فورك، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى: 2005م، ص6.
[9] مقالات أبي الحسن الأشعري، محمد بن الحسن بن فورك، ص5.
[10] مقالات أبي الحسن الأشعري، محمد بن الحسن بن فورك، ص5.


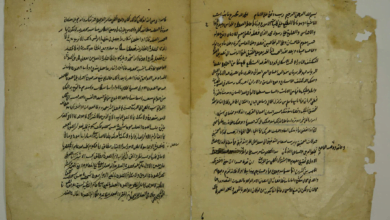


لم أفهم كلام اللاحمي ولا وجه دخوله في المقال ..
لكن المقال عميق وجذوري .. والكلام محرر
شكر الله لكم