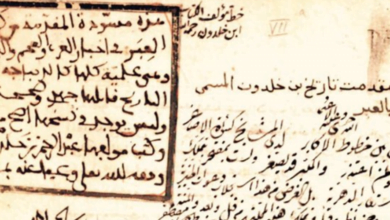عبد الرحمن الموسى
في نهاية زقاق صغير، وعند منعطفه الضيق، أبصرته من بعيد كما أبصرني، كاد أن يتظاهر بأنه لم يرني لولا أنه لم يكن سوانا على ذلك الطريق حينها، أقبل علي متثاقلاً ومد يده على استحياء، سألته عن أخباره سريعاً كما سألني عن أخباري، كيف حالك؟ كيف حال الأهل؟ أسئلة روتينية باهتة لا تتغير إجاباتها بين “الغرباء” مطلقاً، أجبته وأجابني، في يوم ما كان هذا الغريب صديقاً لا أكاد أغيب عنه ثلاث ليال متتالية، ثم مضى كل واحد منا نحو مراده، تذكرت عندها قصة قصيرة دوّنها مريد البرغوثي في سيرته يقول: “عند اللقاء مع صحبة الماضي تجد أن كل شيء قد اختلف، ذات يوم وعلى سبيل الدعابة المعتادة بيني وبينها قلت لسيدة مجرية خفيفة الظل دائمة المزاح تساعدنا في المطبعة التي نصدر منها مجلة الاتحاد في بودابست:
- كل صديقاتي هجرنني يا “جوجا” ماذا أفعل لاستردادهن؟
فإذا بها تجيبني إجابة لم أنسها منذ ذلك اليوم، قالت جوجا:
- لدينا في المجر مثل شعبي يقول: طبخة الملفوف يمكن تسخينها إذا بردت، لكن مذاقها الأصلي لا يعود أبداً.
ضاع المذاق الأصلي لتلك الأيام! ضاع بالفعل.“[1]
فهل ضاع الأصدقاء؟
لكم سرحت بفكري كثيراً وأنا أسمع صديقاً يتحدث بلهفة متّقدة ولست أدرك مقالته، أكتم في صدري نشوة حالمة، فرحة عمر باذخة، قلباً طروباً، قهقهة لا صوت لها، دموع فرح لا ترى، حمداً لله لا ينقضي، شكراً لا ينتهي، يفزعني من سكرتي هذه قبضة يده المتلهفة وهو يقول لي: “أنت معي؟“
أتساءل في نفسي قبل أن أجيبه: ما هو سرّ الصداقة؟ ما هو سرّ الـ “معي؟” هذه؟ ليست المتعة ولاشك، فالمتع التي تأتي من الغرباء -في كثير من الأحيان- أكثر إثارة من غيرهم، وليس هو مجرد الذكريات المشتركة التي عشناها سوية، فكم هو حجم الأصدقاء الذين تغصّ بهم ذاكرتك دون أن تعرف شيئاً من أخبارهم اليوم؟ أما مجرد عواطف المودة المتجهة نحوهم، فكثيرة هي مشاعر الحب التي يشترك فيها الأصدقاء وغيرهم من الأبناء والإخوة والأمهات، فما هو إذن سرّ الصداقة؟ أيكون سرّها مجرد الاهتمامات المشتركة؟ إن كنتَ تظن ذلك فإني لا أظنه في الحقيقة، فكثيرون هم الذين يشاركونني اهتمامات مختلفة وعديدة وليسوا أصدقاء بعد، ولن يكونوا كذلك أيضاً، أذكر أنني قرأت ذات نهار غائم عبارة لطيفة للمنفلوطي الأديب يقول فيها: “أقرب ما تكون النفوس إلى النفوس إذا جمعتها في صعيد واحد هموم الحياة المشتركة“[2]، وبقدر طربي لها يومئذ، بقدر رفضي لها اليوم، ومنذ ذلك الصباح الذي دلفت فيه إلى المدرسة وأنا أتقلب بين اهتمامات عمريّة عديدة، لا يكاد يخلو اهتمام منها من زملاء أتعرف عليهم من خلالها، وكلما طويت صفحة من اهتمام ما؛ طويت صفحة من معارف كثيرة أتجاوزهم نحو غيرهم، وأظننا لا زلنا نبحث في مكان خاطئ أليس كذلك؟ فلم يكن سرّ الصداقة متعلقاً بجانب من ذلك بالتحديد، إن لها معنى أكبر منه ولاشك، أخبرني أحدهم ذات مرة أن صداقاته “نسبية“، وبعيداً عن هذه المفردة الباهتة والتي ظلت “موضة لغوية” مدة طويلة، إلا أنني لم أفهمه جيداً حينها، فالصداقة من طبعها الثبات والدوام، وكونها نسبية فهذا معنى ينقضها في ذاتها، أجابني على عجلة من أمره: “عبدالرحمن، لا تنشغل كثيراً بهذا السؤال، فلكل عمر أصدقاء ولكل مرحلة صحبة، ثم مضى مسرعاً“.
عندما أجول ببصري من حولي يرهقني صداع عارض كلما تذكرت جملته المعترضة تلك، أظنني قد انشغلت بها أكثر مما ينبغي، فهل هذا هو بؤس الصداقة حقاً، أن لا تدرك حقيقتها إلا في وقت متأخر؟!
في كتابها “أكثر خمسة أشياء يندم عليها المرء عند الموت” ذكرت “بروني بير” قصة ملهمة لأحد مرضاها الذين عقدت لهم فصلاً كاملاً في مذكراتها الماتعة، كان رجلاً هرماً طاعناً في السن قد بلغ الثمانين من عمره ولا يزال يتمتع بنشاط جيد رغم المرض الذي حاصره، وكان يتحدث معها كثيراً عن حياته وأحفاده الذين يزورونه باستمرار وعن أصدقائه أيضاً، لم تكن “بروني بير” (المؤلفة) آنذاك تحفل بصداقات كثيرة وجيدة لظروف عملها المختلفة، وقد لاحظ هذا الرجل اللطيف ذلك من خلال حوارهما سوية، فبينما هو يؤكد أهمية الصداقة للإنسان قال جملة -كأنما سمعتها بصوته الأجشّ لشدة ما علقت في لجّة الذاكرة منذ ذلك اليوم-: “إن الصداقة الجيدة تحفزنا؛ فجمال الصداقة ينبع من قبول الناس لنا كما نحن، وقبولهم الأشياء التي نتشارك فيها، إن الصداقة هي أن يتم تقبلك كما أنت، ليس كما يريدك شخص آخر“[3]، ياللأبّهة! فهل كان هذا هو سرّ الصداقة حقاً؟ ليس بعد! فلا شك أن ثمة أمراً آخر، أمراً من شأنه أن يحمي هذا الصداقة من الزوال، من شأنه أن يحرسها من كل المنغصات، من شأنه أن يحفظها من صروف الدهر ولأوائه، من شأنه أن يتجسد ضماناً لها من الإخفاق، ومن سرقة الحساد، ومن أنانية الذات، ومن تقلبات الأيام؛ إنها “المروءة“، ذلك الرّقيب الذي يحمي صداقتنا من الزوال والعبث والتقهقر والضياع، فالحب وحده لا يكفي! والذكريات المزدحمة لا تغني، وكثرة اللقيا والحديث ليست سوى دلالة يتيمية بائسة، كم هو الوقت الذي تقضيه مع زملاء عملك في الحديث والضحك والمتعة، ثم تجد قلبك ينصرف نحو صديقك الذي قلّما التقيته أكثر من مرة واحدة في الأسبوع؟
حقاً إن شطراً من سرّ الصداقة يكمن في تقبل الآخرين لنا كما نحن، ذلك التقبل الأبدي الممزوج بالمودة والصدق، المحاط بحبل من الذكريات العذبة الجميلة، ولنصطلح على ذلك إن شئت بـ “المؤالفة“، ألا يغريك أن هذا المعنى الظريف مستمد من “ألِف“، والذي يدل على المطاوعة والاعتياد والأنس، ياللبهاء!
وأنا أظنك ممن يدرك أن “المؤالفة” لا يلزم منها تماثل الرأي، أو اتفاق الطبع، فهذا وإن كان معنى ممكناً إلا أنه ليس بلازم له، نقل ابن حزم في معرض حديثه عن لطائف المتضادات جملة من الأصدقاء المتصافين في الصحبة المختلفين في الرأي، ومن جملة من ذكرهم الشاعرين الكميت والطرماح، فـ”الكميت بن زيد مضري عصبي كوفي شيعي، والطرماح بن حكيم يماني عصبي شامي خارجي، وكلاهما شاعر مفلق، كانا صديقين متصافيين على عظيم تضادهما من كل وجه!“[4]، فياللطرافة! ومما يحسن أن ينقل في مثل هذا الموضع؛ ما تعرض له النووي أثناء شرحه حديث: “الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف” (مسلم ٢٦٣٨) قال: “وقيل: لأنها خلقت مجتمعة (أي الأرواح) ثم فُرّقت في أجسادها فمن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه“[5]، وانظر لقوله: “بشيمه” تدرك أن الأمر ليس مجرد اختلاف رأي أو اتفاقه، أو تماثل طبع أو تقاربه، فالعقلاء لا تغريهم هذه المظاهر والهيئات، وإنما المؤالفة الروحية التي تورث أماناً نفسياً وإيماناً عذباً صادقاً، وليس ذا لوحده كاف كما تعلم، فالمؤالفة تفسُد إن لم تحرسها المروءة مما ينغصها، وتحفظها مما يوكفها ويقدح بها، ولأن ابن حزم إن ذكر في موضع فلا بد أن يذكر فيه مرة أخرى؛ فمما يطرب ويبهج تعريفه للصداقة في رسالته المفلّقة “مداواة النفوس والأخلاق والسير” يقول: “حدّ الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون المرء يسوءه ما ساء الآخر، ويسرّه ما سرّه، فما سفل عن هذا فليس صديقاً ومن حمل هذه الصفة فهو صديق“[6]، ألا ترى أن هذا الحدّ يغنيك عن كلّ التعريفات المتنوعة لمعنى الصداقة، فهو يجمع كل ود ومؤالفة ومروءة تثمر قبولاً صادقاً وفهماً كاملاً وثقة مستمدة من الآخر، ويمنع كل حسد وتباغض وتنافر وشك واختلاف ونحوه، ثم مضى ابن حزم في التحذير من لصوص الصداقة الذين لا يجمعهم سوى المصادقة على الأطماع وقلة المروءات، ورغّب بإخوان الصفاء الذين “لا يُكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستضلاع والمشاركة والعفة … وبكل حالة محمودة“[7]، ألا يدهشك حجم الفضائل المجتمعة في الجملة السابقة؟ وهذا هو حقيقة معنى المروءة التي هي كمالات الأخلاق وذروتها، وفي معنى ذلك حكى أبو حيان التوحيدي في مطلع كتابه البديع “الصداقة والصديق” حواراً ساحراً مع أبي سليمان السجستاني عن صديقه ابن سيار -على ما بينهما من الاختلاف البالغ، فالأول معنيّ بالفلسفة والآخر معنيّ بالقضاء، والأول من سجستان والآخر من البصرة- يقول: “قلت لأبي سليمان محمد بن ظاهر السجستاني: إني أرى بينك وبين ابن سيار القاضي ممازجة نفسية، وصداقة عقلية، ومساعدة طبيعية، ومواتاة خلقية، فمن أين هذا؟ وكيف هو؟!
فقال:
- يا بني، اختلطت ثقتي به بثقته بي فاستفدنا طمأنينة وسكونًا لا يرثّان على الدهر، ولا يحولان بالقهر … فبيننا مشاكلة عجيبة ومظاهرة غريبة، حتى أنَّا نلتقي كثيرًا في الإرادات، والشهوات، والطلبات، وربما تزاورنا فيحدثني بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل فأجدها شبيهة بأمور حدثت لي في ذلك الأوان حتى كأنها قسائم بيني وبينه، أو كأني هو فيها أو هو أنا …
- فقلت: هل تجد عليه في شيء، أو يجد عليك في شيء؟
- فقال: وجدي به في الأول قد حجبني عن موجدتي عليه في الثاني، على أنه يكتفي مني فيما خالف هواي باللمحة الضئيلة، وأكتفي أنا أيضًا منه في مثل ذلك بالإشارة القليلة، وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية عن غيرنا كأننا نتحدث عن قوم آخرين، ويكون لنا في ذلك مقنع، وإليه مفزع، وقلما نجتمع إلا ويحدثني عني بأسرار ما سافرت عن ضميري إلى شفتي، ولا ندت عن صدري إلى لفظي، وذاك للصفاء الذي نتساهمه، والوفاء الذي نتقاسمه، والباطن الذي نتفق عليه، والظاهر الذي نرجع إليه، والأصل الذي رسوخنا فيه، والفرع الذي تشبثنا به، والله ما يسرني بصداقته حمر النعم، وإذا كنت أعشق الحياة لأني بها أحيا، كذلك أعشق كل ما وصل الحياة بالحياة وجنى لي ثمرتها، وجلب إلي روحها، وخلط بي طيبها وحلاوتها.
ثم استرسل قائلاً:
- الصداقة التي تدور بين الرغبة والرهبة شديدة الاستحالة، وصاحبها من صاحبه في غرور، والزلة فيها غير مأمونة، وكسرها غير مجبور.“[8]
فياللتجلّة والوقار والتيه والشرف! أي معنى أعمق من هذا وأكثر ترفاً، وأين هؤلاء من قوم بأخرة يفسدون الصداقة عند أدنى هفوة، ويتقاطعون عند أقلّ جريرة، ويبطلونها مخافة كل همّ، ويتبجحون بذلك وأنى لهم جرأتهم هذه!
إن الصداقة الحقّة معنى مجتمع من الألفة والتقبّل والثقة والمروءة والمودة قد امتزج بعضها ببعض لا تكاد تميّز بين خصالها أو تفصلها عن بعضها، يهتم الصديق بصديقه، يحزنه ما يحزنه، يفرحه ما يفرحه، يحب له ما يحب لنفسه، يستمع إلى أحواله كأنها أحواله هو، وإلى أخباره كأنها أخباره هو، فإن صادف أن اشتركا سوية الاهتمام بشأن ما، أو اتفق لهما أن تماثلت أحوالهما، فذلك رونق يجمّل صداقتهما ويزيدها حسناً على حسن وترفاً على ترف، إلا أننا في زمن كهذا الزمن؛ أصبح الودّ سيالاً بطبعه، وباتت المتعة سلطاناً على المودة والمحبة، والملل معيار مقوّم للصحبة، وبخل النفس سمة العلائق، فلا الودّ مستحكم مبذول، ولا المروءة حاكمة، وما بات حسن العهد من الإيمان، يذكرني ذلك بكلمات لابن المقفع نقلها ابن حبّان -قد رقصت في فضاء ذاكرتي لما قرأتها حتى يئست من سكونها- حيث يقول:”ورأس المودة الاسترسال، وآفتها الملالة، ومن أضاع تعهد الود من إخوانه حرم ثمرة إخائهم، وآيس الإخوان من نفسه، ومن ترك الإخوان مخافة تعاهد الود يوشك أن يبقى بغير أخ، كما أن من ترك نزع الماء إشفاقاً على رشائه يوشك أن يموت عطشاً“[9]، بالله عليك ألا يطربك تكراره لكلمة “الإخوان” وهو يريد الأصدقاء؟ ثم ألا يطربك -أيضاً- أن كلمة “الصديق” تعود في اشتقاقها إلى “الصدق”!
وعوداً إلى ذلك الرجل المسنّ اللطيف في محاورته الماتعة مع ممرضته “بروني بير”، إذ كان يسترسل في عتاب شجيّ لبعض أقرانه من صحبة الماضي قائلاً: “سیدركون ذلك بعد فوات الأوان! إن هذا الأمر لا ینطبق فقط على أبناء جیلي، ولكن انظري لمن هم أصغر في السن ممن تلهیهم الحیاة وینشغلون للغایة، ولا یوفرون حتى القلیل من الوقت لأنفسهم بین الحین والآخر لفعل أشیاء تجعلهم سعداء على المستوى الشخصي، إنهم یفقدون هویتهم تماماً، وقلیل من الوقت مع أصدقائهم یذكرهم ما كانوا علیه قبل أن یصبحوا آباء أو أمهات أو أجداد، هل تفهمین ما أعنیه؟!“[10]، وهذا هو بؤس الصداقة المظلم، أن لا تدرك معناها إلا بعد فوات الأوان!
حقاً لسنا أبناء الخامسة أو الثامنة عشر، نعبّ من مخزون الوقت كما يحلو لنا، تسابق الريح خفةُ نفوسنا، وأحلامنا أكبر من همومنا، لكننا اليوم أبناء العشرين والثلاثين والأربعين، صحيح أننا نجاهد في تحصيل طموحاتنا وتحقيق توازن معقول في حياتنا، إلا أننا نتحلى بمروءة تجملنا بين أصحابنا، ونتعقل مآرب أفعالنا، وندرك بوعي ناضج ما يدور من حولنا، على أن أصدقاء الفتوّة والماضي عروق محبتهم متجذرة في الفؤاد لا تنخلع منه إلا بتقطيع نياطه، فإما أن تروى محبتهم على الدوام وإما أن تموت جذورهم داخل أفئدتنا، لذا كان العتب عليهم بقدر افتقادهم، والموجدة عليهم بحجم وحشة بُعدهم، سخرت بأسىً عندما قرأت مقولة تنسب للرافعي يقرر فيها ذلك بقوله: “ومن هذه الناحية كان البغض بين الحبيبين -حين يقع- أعنف ما في الخصومة؛ إذ هو تقاتل روحين على تحليل أجزائهما الممتزجة!”[11]
يكرر صاحبي من جديد نداءه بصوت متلهف:
- “عبدالرحمن! معي أنت ولا مب معي؟!”
أدرك أنني وإن لم أكن معه في حديثه، إلا أنني أقرب ما أكون إليه، الأصدقاء روح قدسية، نعيم من الجنة معجل، هبة سماوية، أي شيء سنكون لولا لطف الله علينا بهم؟ وإلى أي حدٍ ستكون الدنيا قاتمة بدونهم؟ وكيف يتجلى لنا معنى البهجة والألفة لولا وجودهم؟ ألا ترى أن الله -جل جلاله- في معرض تشويقه لعباده بالجنة وما فيها من النعيم المقيم، لا يغيب في سرده لذلك النعيم عن ذكر نعيم آخر لا يقلّ عنه: “إخواناً على سرر متقابلين“(سورة الحجر ٤٧) بل ويصوّر مشهدهم إمعاناً في ذكر نعيمهم فيها: متكئين ومتقابلين وعلى سرر مرفوعة وموضونة ومصفوفة! لأنه “لا سرور يعدل صحبة الإخوان، ولا همّ يعدل فراقهم“.[12]
[1] رأيت را م الله – مريد البرغوثي صـ٩١.
[2] النظرات للمنفلوطي ٣ /١٨٢، وقد تتوجه عبارة المنفلوطي في قصده بالهموم التي هي قسيمة المتاعب والكروب ومصاعب الحياة، دون أن يقصد بذلك الاهتمامات المترفة التي يشتركون فيها برغبة منهم.
[3] أكثر خمسة أشياء يندم عليها المرء عند موته، صـ ١٢٤.
[4] رسائل ابن حزم ٢ / ١١٣.
[5] شرح النووي لصحيح مسلم ١٦ / ١٨٥.
[6] رسائل ابن حزم ١ / ٣٦١.
[7] المرجع السابق.
[8] الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي صـ٣٢.
[9] روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، صـ ٩٠.
[10] المصدر نفسه.
[11] السحاب الأحمر – الرافعي.
[12] ذكرها بنصها ابن المقفع في كتابه “كليلة ودمنة” صـ ١٩٢، ورويت عن الشافعي في شعب الإيمان للبيهقي [٨٦٥١].